|
||||||
| المنتدى الإسلامي خاصة بطلاب العلم الشرعي ومحبيه، والقضايا الدينية |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
|
فصل مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث وهذا منها
والمعني الذي دل عليه هذا الحديث: أصل عظيم من أصول الدين، بل هو أصل كل عمل؛ ولهذا قالوا: مدار الإسلام على ثلاثة أحاديث فذكروه منها، كقول أحمد حديث: «إنما الأعمال بالنيات»، و«مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» «والحلال بَيِّنٌ والحرام بين»، ووجه هذا الحديث أن الدين فِعْلُ ما أمر الله به، وتَرْك ما نهى عنه. فحديث الحلال بين فيه بيان ما نهى عنه. والذي أمر الله به نوعان: أحدهما: العمل الظاهر، وهو ما كان واجبًا أو مستحبًا، والثاني: العمل الباطن، وهو إخلاص الدين لله. فقوله: «من عمل عملا» إلخ ينفي التقرب إلى الله بغير ما أمر الله به؛ أمر إيجاب أو أمر استحباب. وقوله: «إنما الأعمال بالنيات» إلخ يبين العمل الباطن، وأن التقرب إلى الله إنما يكون بالإخلاص في الدين لله؛ كما قال الفضيل في قوله تعالى: { لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا } قال: أخلصه وأصوبه، قال: فإن العمل إذا كان خالصًا، ولم يكن صوابًا لم يقبل، وإذا كان صوابًا، ولم يكن خالصًا لم يقبل، حتى يكون خالصًا صوابًا. والخالص: أن يكون لله، والصواب: أن يكون على السنة، وعلى هذا دل قوله تعالى: { فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا } فالعمل الصالح هو ما أمر الله به ورسوله؛ أمر إيجاب أو أمر استحباب، وألا يشرك العبد بعبادة ربه أحدًا، وهو إخلاص الدين لله. وكذلك قوله تعالى: { بَلَي مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ } الآية وقوله: { وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا } وقوله: { وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَي } فإن إسلام الوجه لله يتضمن إخلاص العمل لله، والإحسان هو إحسان العمل لله وهو فعل ما أمر به فيه كما قال تعالى: { إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا } فإن الإساءة في العمل الصالح تتضمن الاستهانة بالأمر به، والاستهانة بنفس العمل، والاستهانة بما وعده الله من الثواب، فإذا أخلص العبد دينه لله وأحسن العمل له كان ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فكان من الذين لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فصل لفظ النية في كلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة، ونحو ذلك، تقول العرب: نواك الله بخير، أي: أرادك بخير، ويقولون: نَوَي مَنْوِيه، وهو المكان الذين ينويه، يسمونه نوي، كما يقولون: قبض بمعني مقبوض، والنية يعبر بها عن نوع من إرادة، ويعبر بها عن نفس المراد، كقول العرب: هذه نيتي، يعني: هذه البقعة هي التي نويت إتيانها، ويقولون: نيته قريبة أو بعيدة، أي: البقعة التي نوي قصدها، لكن من الناس من يقول: إنها أخص من الإرادة؛ فإن إرادة الإنسان تتعلق بعمله وعمل غيره، والنية لا تكون إلا لعمله، فإنك تقول: أردت من فلان كذا، ولا تقول: نويت من فلان كذا. فصل وقد تنازع الناس في قوله صلى..: «إنما الأعمال بالنيات» هل فيه إضمار، أو تخصيص؟ أو هو على ظاهره وعمومه؟ فذهب طائفة من المتأخرين إلى الأول، قالوا: لأن المراد بالنيات الأعمال الشرعية التي تجب أو تستحب، والأعمال كلها لا تشترط في صحتها هذه النيات، فإن قضاء الحقوق الواجبة من الغُصُوب والعَوَارِي والودائع والديون تَبْرَأ ذمة الدافع، وإن لم يكن له في ذلك نية شرعية، بل تبرأ ذمته منها من غير فعل منه، كما لو تسلم المستحق عين ماله، أو أطارت الريح الثوب المودع أو المغصوب، فأوقعته في يد صاحبه، ونحو ذلك. ثم قال بعض هؤلاء: تقديره إنما ثواب الأعمال المترتبة عليها بالنيات، أو إنما تقبل بالنيات، وقال بعضهم: تقديره إنما الأعمال الشرعية، أو إنما صحتها، أو إنما إجزاؤها، ونحو ذلك. وقال الجمهور: بل الحديث على ظاهره وعمومه، فإنه لم يرد بالنيات فيه الأعمال الصالحة وحدها، بل أراد النية المحمودة والمذمومة، والعمل المحمود والمذموم؛ ولهذا قال في تمامه: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» إلخ، فذكر النية المحمودة بالهجرة إلى الله ورسوله فقط، والنية المذمومة وهي الهجرة إلى امرأة أو مال، وهذا ذكره تفصيلا بعد إجمال، فقال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، ثم فصل ذلك بقوله: «فمن كانت هجرته» إلخ. وقد رُوِي أن سبب هذا الحديث: أن رجلا كان قد هاجر من مكة إلى المدينة لأجل امرأة كان يحبها تُدْعي أم قيس، فكانت هجرته لأجلها، فكان يسمي مهاجر أم قيس، فلهذا ذكر فيه: «أو امرأة يتزوجها وفي رواية ينكحها» فخص المرأة بالذكر لاقتضاء سبب الحديث لذلك. والله أعلم. والسبب الذي خرج عليه اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه باتفاق الناس، والهجرة في الظاهر هي: سفر من مكان إلى مكان، والسفر جنس تحته أنواع مختلفة تختلف باختلاف نية صاحبه. فقد يكون سفرًا واجبًا، كحج أو جهاد متعين، وقد يكون محرمًا؛ كسفر العَادِي لقطع الطريق، والباغي على جماعة المسلمين، والعبد الآبق. والمرأة الناشز. ولهذا تكلم الفقهاء في الفرق بين العاصي بسفره، والعاصي في سفره، فقالوا: إذا سافر سفرًا مباحًا؛ كالحج والعمرة والجهاد جاز له فيه القصر والفطر باتفاق الأئمة الأربعة، وإن عصي في ذلك السفر. وأما إذا كان عاصيًا بسفره؛ كقطع الطريق، وغير ذلك فهل يجوز له الترخص برخص السفر كالفطر والقصر؟ فيه نزاع: فمذهب مالك، والشافعي، وأحمد: أنه لا يجوز له القصر والفطر، ومذهب أبي حنيفة يجوز له ذلك، وإذا كان النبي صلى.. قد ذكر هذا السفر وهذا السفر علم أن مقصوده ذكر جنس الأعمال مطلقًا، لا نفس العمل الذي هو قربة بنفسه كالصلاة والصيام، ومقصوده ذكر جنس النية، وحينئذ يتبين أن قوله: «إنما الأعمال بالنيات» مما خصه الله تعالى به من جوامع الكلم، كما قال: «بعثت بجوامع الكلم»، وهذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع التي بعث بها، فإن كل عمل يعمله عامل من خير وشر هو بحسب ما نواه، فإن قصد بعمله مقصودًا حسنًا كان له ذلك المقصود الحسن، وإن قصد به مقصودًا سيئًا كان له ما نواه. فصل ولفظ النية يراد بها النوع من المصدر، ويراد بها المنوي، واستعمالها في هذا لعله أغلب في كلام العرب، فيكون المراد إنما الأعمال بحسب ما نواه العامل، أي: بحسب منويه؛ولهذا قال في تمامه: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» فذكر ما ينويه العامل ويريده بعمله وهو الغاية المطلوبة له، فإن كل متحرك بالإرادة لابد له من مراد. ولهذا قال صلى..: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأقبحها حرب ومرة، وأصدقها حارث وهمام» فإن كل آدمي حارث وهمام، والحارث هو العامل الكاسب، والهمام الذي يهم ويريد. قال تعالى: { مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ } فقوله حرث الدنيا أي: كسبها وعملها؛ ولهذا وضع الحريري مقاماته على لسان الحارث بن همام؛ لصدق هذا الوصف على كل أحد. فصل ولفظ النية يجري في كلام العلماء على نوعين: فتارة يريدون بها تمييز عمل من عمل، وعبادة من عبادة، وتارة يريدون بها تمييز معبود عن معبود، ومعمول له عن معمول له. فالأول: كلامهم في النية: هل هي شرط في طهارة الأحداث؟ وهل تشترط نية التعيين والتبييت في الصيام؟ وإذا نوي بطهارته ما يستحب لها هل تجزيه عن الواجب؟ أو أنه لابد في الصلاة من نية التعيين ونحو ذلك؟ والثاني: كالتمييز بين إخلاص العمل لله، وبين أهل الرياء والسمعة، كما سألوا النبي صلى..عن الرجل يقاتل شجاعة وحَمِيَّة ورياءً، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» وهذا الحديث يدخل فيه سائر الأعمال، وهذه النية تميز بين من يريد الله بعمله والدار الآخرة، وبين من يريد الدنيا؛ مالا وجاها ومدحًا وثناءً وتعظيمًا، وغير ذلك، والحديث دل على هذه النية بالقصد، وإن كان قد يقال: إن عمومه يتناول النوعين، فإنه فرق بين من يريد الله ورسوله، وبين من يريد دنيا أو امرأة، ففرق بين معمول له ومعمول له. ولم يفرق بين عمل وعمل. وقد ذكر الله تعالى الإخلاص في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى: { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ }، وقوله: { فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ } . وقوله: { قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي } وغير ذلك من الآيات. وإخلاص الدين هو أصل دين الإسلام؛ ولذلك ذم الرياء في مثل قوله: { فَوَيْلٌ لِّلْمُصلينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ } وقوله: { وَإِذَا قَامُواْ إلى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلًا } وقال تعالى: { كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ } الآية وقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاء النَّاسِ } الآية فصل وقد اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها؛ كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية، وتنازعوا في الطهارة، مثل: مَنْ يكون عليه جنابة فينساها، ويغتسل للنظافة، فقال مالك والشافعي وأحمد: النية شرط لطهارة الأحداث كلها. وقال أبو حنيفة: لا تشترط في الطهارة بالماء بخلاف التيمم، وقال زُفَر: لا تشترط لا في هذا ولا في هذا، وقال بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد: تشترط لإزالة النجاسة، وهذا القول شاذ؛ فإن إزالة النجاسة لا يشترط فيها عمل العبد، بل تزول بالمطر النازل، والنهر الجاري، ونحو ذلك، فكيف تشترط لها النية؟ وأيضا، فإن إزالة النجاسة من باب التروك لا من باب الأعمال؛ ولهذا لو لم يخطر بقلبه في الصلاة أنه مجتنب النجاسة صَحَّت صلاته إذا كان مجتنبًا لها؛ ولهذا قال مالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه: لو صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها إلا بعد الصلاة لم يُعِد؛ لأنه من باب التروك. وقد ذكر الله عن المؤمنين قولهم: { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } وثبت عن النبي صلى.ز : «أن الله تعالى قال قد فعلت» فمن فعل ما نهى عنه ناسيًا أو مخطئًا فلا إثم عليه، بخلاف من ترك ما أمر به، كمن ترك الصلاة فلابد من قضائها. ولهذا فرق أكثر العلماء في الصلاة والصيام والإحرام بين من فعل المحظور ناسيًا، وبين من ترك الواجب ناسيًا، كمن تكلم في الصلاة ناسيًا، ومن أكل في الصيام ناسيًا، ومن تطيب أو لبس ناسيًا في الإحرام. والذين يوجبون النية في طهارة الأحداث يحتجون بهذا الحديث على أبي حنيفة، وأبو حنيفة يسلم أن الطهارة غير المنوية ليست عبادة ولا ثواب فيها، وإنما النزاع في صحة الصلاة بها، فقوله صلى..: «إنما الأعمال بالنيات» لا يدل على محل النزاع إلا إذا ضمت إليه مقدمة أخري، وهو أن الطهارة لا تكون إلا عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، وهذه المقدمة إذا سلمت لم تَحْتَجْ إلى الاستدلال بهذا، فإن الناس متفقون على أن ما لا يكون إلا عبادة لا يصح إلا بنية، بخلاف ما يقع عبادة وغير عبادة، كأداء الأمانات وقضاء الديون. وحينئذ، فالمسألة مدارها على أن الوضوء هل يقع غير عبادة؟ والجمهور يحتجون بالنصوص الواردة في ثوابه، كقوله: «إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء» وأمثال ذلك، فيقولون: ففيه الثواب لعموم النصوص، والثواب لا يكون إلا مع النية، فالوضوء لا يكون إلا بنية. وأبو حنيفة يقول: الطهارة شرط من شرائط الصلاة، فلا تشترط لها النية؛ كاللباس وإزالة النجاسة، وأولئك يقولون: اللباس والإزالة يقعان عبادة وغير عبادة؛ ولهذا لم يَرِد نص بثواب الإنسان على جنس اللباس والإزالة، وقد وردت النصوص بالثواب على جنس الوضوء. وأبو حنيفة يقول: النصوص وردت بالثواب على الوضوء المعتاد، وعامة المسلمين إنما يتوضؤون بالنية، والوضوء الخالي عن النية نادر لا يقع إلا لمثل من أراد تعليم غيره، ونحو ذلك، والجمهور يقولون: هذا الوضوء الذي اعتاده المسلمون هو الوضوء الشرعي الذي تصح به الصلاة، وما سوي هذا لا يدخل في نصوص الشارع، كقوله صلى..: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، فإن المخاطبين لا يعرفون الوضوء المأمور به إلا الوضوء الذي أثني عليه، وحث عليه، وغير هذا لا يعرفونه، فلا يقصد إدخاله في عموم كلامه، ولا يتناوله النص. فصل وأما النية التي هي إخلاص الدين لله فقد تكلم الناس في حَدِّها، وحد الإخلاص، كقول بعضهم: المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل، ولا يحب أن يطلع الناس على مَثَاقِيل الذَّرِّ من عمله، وأمثال ذلك من كلامهم الحسن. لكن كلامهم يتضمن الإخلاص في سائر الأعمال، وهذا لا يقع من سائر الناس، بل لا يقع من أكثرهم، بل غالب المسلمين يخلصون لله في كثير من أعمالهم؛ كإخلاصهم في الأعمال المشتركة بينهم، مثل صوم شهر رمضان، فغالب المسلمين يصومونه لله، وكذلك مَنْ داوم على الصلوات فإنه لا يصلي إلا لله عز وجل، بخلاف من لم يحافظ عليها فإنما يصلي حياءً، أو رياء، أو لعلة دنيوية؛ ولهذا قال صلى..فيما رواه الترمذي: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان؛ فإن الله تعالى يقول: { إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَي الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ }» الآية ومن لم يصل إلا بوضوء واغتسال فإنه لا يفعل ذلك إلا لله؛ ولهذا قال صلى ...فيما رواه أحمد، وابن ماجة من حديث ثوبان عنه أنه قال: «استقيموا ولن تُحْصُوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فإن الوضوء سر بين العبد وبين الله عز وجل»، وقد ينتقض وضوؤه ولا يدري به أحد، فإذا حافظ عليه لم يحافظ عليه إلا لله سبحانه، ومن كان كذلك لا يكون إلا مؤمنا، والإخلاص في النفع المتعدي أقل منه في العبادات البدنية؛ ولهذا قال في الحديث المتفق على صحته: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» الحديث. فصل والنية محلها القلب باتفاق العلماء؛ فإن نوي بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم، وقد خَرَّج بعض أصحاب الشافعي وجهًا من كلام الشافعي غلط فيه على الشافعي؛ فإن الشافعي إنما ذكر الفرق بين الصلاة والإحرام بأن الصلاة في أولها كلام، فظن بعض الغالطين أنه أراد التكلم بالنية، وإنما أراد التكبير، والنية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله فلابد أن ينويه ضرورة، كمن قدم بين يديه طعامًا ليأكله فإذا علم أنه يريد الأكل فلابد أن ينويه، وكذلك الركوب وغيره، بل لو كُلِّف العباد أن يعملوا عملًا بغير نية كلفوا ما لا يطيقون؛ فإن كل أحد إذا أراد أن يعمل عملًا مشروعًا، أو غير مشروع فعلمه سابق إلى قلبه، وذلك هو النية، وإذا علم الإنسان أنه يريد الطهارة والصلاة والصوم فلابد أن ينويه إذا علمه ضرورة، وإنما يتصور عدم النية إذا لم يعلم ما يريد، مثل: من نسي الجنابة واغتسل للنظافة أو للتبرد، أو من يريد أن يُعَلِّم غيره الوضوء ولم يرد أنه يتوضأ لنفسه، أو من لا يعلم أن غدًا من رمضان فيصبح غير ناوٍ للصوم. وأما المسلم الذي يعلم أن غدًا من رمضان وهو يريد صوم رمضان فهذا لابد أن ينويه ضرورة، ولا يحتاج أن يتكلم به، وأكثر ما يقع عدم التبييت والتعيين في رمضان عند الاشتباه، مثل: من لا يعلم أن غدًا من رمضان أم لا، فينوي صوم رمضان مطلقًا أو يقصد تطوعًا، ثم يتبين أنه من رمضان، ولو تكلم بلسانه بشيء وفي قلبه خلافه كانت العبرة بما في قلبه لا بما لفظ به، ولو اعتقد بقاء الوقت فنوي الصلاة أداء، ثم تبين خروج الوقت، أو اعتقد خروجه فنواها قضاء، ثم تبين له بقاؤه أجزأته صلاته بالاتفاق. ومن عرف هذا تبين له أن النية مع العلم في غاية اليسر لا تحتاج إلى وسوسة وآصار وأغلال؛ ولهذا قال بعض العلماء: الوسوسة إنما تحصل للعبد من جهل بالشرع أو خَبَل في العقل. وقد تنازع الناس: هل يستحب التلفظ بالنية؟ فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب ليكون أبلغ، وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد: لا يستحب ذلك، بل التلفظ بها بدعة؛ فإن النبي وأصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد منهم أنه تكلم بلفظ النية لا في صلاة، ولا طهارة، ولا صيام، قالوا: لأنها تحصل مع العلم بالفعل ضرورة، فالتكلم بها نَوْعُ هَوَسٍ وعبث وهَذَيَان، والنية تكون في قلب الإنسان ويعتقد أنها ليست في قلبه، فيريد تحصيلها بلسانه، وتحصيل الحاصل مُحَال، فلذلك يقع كثير من الناس في أنواع من الوسواس. واتفق العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية، لا لإمام، ولا لمأموم، ولا لمنفرد، ولا يستحب تكريرها، وإنما النزاع بينهم في التكلم بها سرًا: هل يكره أو يستحب؟ فصل لفظة إنما للحصر عند جماهير العلماء، وهذا مما يعرف بالاضطرار من لغة العرب، كما تعرف معاني حروف النفي والاستفهام والشرط، وغير ذلك، لكن تنازع الناس: هل دلالتها على الحصر بطريق المنطوق أو المفهوم؟ على قولين، والجمهور على أنه بطريق المنطوق، والقول الآخر قول بعض مثبتي المفهوم، كالقاضي أبي يعلى في أحد قوليه، وبعض الغلاة من نفاته، وهؤلاء زعموا أنها تفيد الحصر، واحتجوا بمثل قوله: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ } وقد احتج طائفة من الأصوليين على أنها للحصر بأن حرف إن للإثبات وحرف ما للنفي فإذا اجتمعا حصل النفي والإثبات جميعًا، وهذا خطأ عند العلماء بالعربية؛ فإن ما هنا هي ما الكافَّة، ليست ما النافية، وهذه الكافة تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل، وذلك لأن الحروف العاملة أصلها أن تكون للاختصاص؛ فإذا اختصت بالاسم أو بالفعل ولم تكن كالجزء منه عملت فيه، فإن وأخواتها اختصت بالاسم فعملت فيه، وتسمي الحروف المشبهة للأفعال؛ لأنها عملت نصبًا ورفعًا وكثرت حروفها، وحروف الجر اختصت بالاسم فعملت فيه، وحروف الشرط اختصت بالفعل فعملت فيه، بخلاف أدوات الاستفهام فإنها تدخل على الجملتين ولم تعمل، وكذلك ما المصدرية. ولهذا القياس في ما النافية ألا تعمل أيضا على لغة تميم، ولكن تعمل على اللغة الحجازية التي نزل بها القرآن في مثل قوله تعالى: { مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ } و { مَا هَذَا بَشَرًا } استحسانًا لمشابهتها ليس هنا، لما دخلت ما الكافة على إن أزالت اختصاصها، فصارت تدخل على الجملة الاسمية والجملة الفعلية فبطل عملها، كقوله: { إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ } وقوله: { إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } وقد تكون ما التي بعد إن اسمًا لا حرفًا، كقوله: { إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } بالرفع، أي: أن الذي صنعوه كيد ساحر، خلاف قوله: { إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا } فإن القراءة بالنصب لا تستقيم إذا كانت ما بمعني الذي، وفي كلا المعنيين الحصر موجود، لكن إذا كانت ما بمعني الذي فالحصر جاء من جهة أن المعارف هي من صِيَغ العموم، فإن الأسماء إما معارف وإما نكرات، والمعارف من صيغ العموم والنكرة في غير الموجب كالنفي وغيره من صيغ العموم، فقوله: { إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ } تقديره: إن الذي صنعوه كيد ساحر. وأما الحصر في إنما فهو من جنس الحصر بالنفي والاستثناء، كقوله تعالى: { مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا } { وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ } والحصر قد يعبر عنه بأن الأول محصور في الثاني، وقد يعبر عنه بالعكس، والمعني واحد، وهو أن الثاني أثبته الأول، ولم يثبت له غيره، مما يتوهم أنه ثابت له، وليس المراد أنك تنفي عن الأول كل ما سوي الثاني، فقوله: { إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ } أي: إنك لست ربا لهم، ولا محاسبًا، ولا مجازيًا، ولا وكيلًا عليهم، كما قال: { لَّسْتَ عليهم بِمُصَيْطِرٍ } وكما قال: { فَإِنَّمَا عليكَ الْبَلاَغُ } { مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ } ليس هو إلهًا ولا أمه إلهة، بل غايته أن يكون رسولًا، كما غاية محمد أن يكون رسولًا، وغاية مريم أن تكون صديقة. وهذا مما استدل به على بطلان قول بعض المتأخرين: إنها نبية، وقد حَكَي الإجماع على عدم نبوة أحد من النساء القاضي أبو بكر بن الطيب والقاضي أبو يعلى، والأستاذ أبوالمعالي الجويني، وغيرهم. وكذلك قوله تعالى: { وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ } أي: ليس مخلدًا في الدنيا لا يموت ولا يقتل، بل يجوز عليه ما جاز على إخوانه المرسلين من الموت أو القتل، { أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ على أَعْقَابِكُمْ } نزلت يوم أحد لما قيل: إن محمدا قد قتل، وتلاها الصديق يوم مات رسول الله فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حَي لا يموت، وتلا هذه الآية، فكأن الناس لم يسمعوها حتى تلاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكان لا يوجد أحد إلا يتلوها. 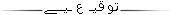
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| يا أمة الإسلام هل من قائد | أمح محمد أحمد | المنتدى الأدبي | 2 | 05-18-2009 11:45 PM |
| الأخلاق في الإسلام | المستكشف | المنتدى الإسلامي | 3 | 04-13-2009 07:18 PM |