|
||||||
| المنتدى الأدبي ميدان للإبداع خاطرة أدبية أوقصة أو رواية أو تمثيلية معبرة أو مسرحية أو ضروب الشعر وأشكاله |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
في المقطع الآتي يطلعنا الشاعر على مضمون المحاورة التي جرت بينه وبين الزائرة الموقرة, بعدما فرغ من تهيئة سبل الراحة لها, من أجل التعرف عليها وعلى أبيها, ثم ينقلنا إلى شخصية الشيخ الشاعر (إغلس) الفذة, فيحدثنا عن مكانته في العلم والكرم والشجاعة ومحاسن الأخلاق, ثم يشيد بمبادرة (إغلس) المباركة في محاولة إنعاش النشاط العلمي في إقليمه, وكل ذلك بأسلوب عجيب ولغة جذلة رائعة, فيقول:
فقلتُ لها: ممَّن؟ أمن أهل بابلٍ... أبيني لنا, أم أنتِ من أهل فارس؟ فإن لا تكوني من أكارم قومهم... فمن كرْمهم, أو من بناتِ المَراقس وإلا, فأنتِ دُرَّةٌ صدفيَّةٌ... ثوتْ حِججاً مغموسةً في المَغاطس فقالت: أبي تَهذي, أبي؟ أوَ لم تكن... بأنسبِ نسَّابٍ وأفرسِ فارس فقلتُ لها: سبحان منك! تنسَّبي... فقالت: ومنكَ! إنني بنتُ هاجس فقلتُ لها: أيُّ الهواجس؟ إنني... أراكِ ابنةَ الوضَّاح خُس بن حابس فقالت: لقد أعييتَني, فعِ أنتسبْ... فقلتُ لها: قولي, يعِ القولَ هاجس ي فقالت: نماني (ابنُ اليماني), ومن تَطبْ... مغارسُه, يطبْ بطيب المَغارس تبسيط المقطع السابق: (فقلتُ لها: ممَّن؟ أمن أهل بابلٍ... أبيني لنا, أم أنتِ من أهل فارس؟ فإن لا تكوني من أكارم قومهم... فمن كرْمهم, أو من بنات المراقس المفردات: بابل: اسم موضع بالعراق, ينسب إليه السحر والخمر, ويُقال ـ واللَّه أعلم ـ: إنّ اللَّه ـ عزّ وجلّ ـ لما أراد أن يُخالِفَ بين أَلْسِنة بني آدمَ بعث ريحاً, فحشرتهم من كلِّ أُفُق إلى بابل, فبلبل اللَّه بها ألسنتهم، ثمّ فرَّقتهم تلك الرِّيحُ في البلاد, والبَلْبَلةُ: بَلْبَلةُ الأَلْسُن المختلفة. فارس: هم الفرس, والفارس: الحاذق بركوب الخيل, و صاحب الفراسة بالكسر الاسم من قولك تفرست فيه خيرا, وهو يتفرس أي يتثبت وينظر, تقول منه رجل فارس النظر. أكارم: جمع كريم, والكرم: ضد اللؤم, السخاء وسعة الصدر, والصفح وحب الأخلاق الحميدة. يقال: تكرَّمَ فلان عما يشينه إذا تنزه، وأَكْرَمَ فسه عن الشائنات, الكرم شجر العنب والكرم أيضا القلادة يقال رأيت في عنقها كرما حسنا من لؤلؤ. كرمهم: الكرْم العنب, ويسمي الكَرْمُ كرْماً؛ لأن الخمر المتخذ منه يحث على السخاء والكَرم, ويأمر بمكارم الأخلاق, فاشتقوا له اسما من الكَرَم للكَرم الذي يتولد منه, فكره النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يسمى أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم، وجعل المرء المؤمن أولى بهذا الاسم الحسن وأنشدوا: والخَمْرُ مشتقَّة المعنى من الكرَمِ؛ ولهذا المعنى سموا الخمر راحاً؛ لأن شاربها يرتاح للعطاء أي يخفّ. المراقس: جمع مرقس: من أسماء امرئ القيس, وسمي امرؤ القيس بذلك؛ لأنه كان يقول الشعر على لسان إبليس, ومرقس من أسماء إبليس عند الجاهلية, ولقب شاعر طائي، واسمه عبد الرحمن أحد بني معن بن عتود, واسم رجل من الرهبان. المحتوى: بعد فراغ الشاعر من توفير سبل الراحة والطمأنينة لزائرته, فاتحها ليماقسها في حوار شيق لطيف؛ تأنيسا لها بمحاورته, حوار سيبقى لوحة فنية خالدة في المتاحف الأدبية, تخطف أنظار المرتادين, فقد استخدم هذا الفنان في تشكيلها مهاراته الفنية بكل إتقان, كما لونها بروائع التلاوين, وأودعها من الإشارات والإيحاءات ما يسلب الألباب مدى الأزمان, وتجلت فيها مقدرته الأدبية وثقافته الحضارية واضحة للعيان, فطاف بالحضارة العربية بفرسانها ومراقسها وشياطين شعرائها, ورهبانها وعماليقها وفصحائها, والحضارة الفارسية بكياسرتها وتيجانيها وتناميقها, وسحرتها, ودنانها وأباريقها, وغاص في محيطات البحار كل عميقها, كل ذلك محاولة منه لإدراك كنه زائرته بعد ما سحرته برونقها, وهي تتمايل في طريقها, وأسكرت عقله ببريقها, لا بارتشاف ريقها, وانطلق الحوار الشيق على مقتضى أدبيات استقبال الضيوف المكرمين, وقانون الدخول في خصوصيات الأذكياء المحترمين, فأبدى الشاعر لزائرته غاية الإعجاب بمنظرها, وطوى في ذلك الاستفسار عن مخبرها زيادة على ما فهمه من ملامح مظهرها, وكان الشاعر يحاول استجلاء حقيقة هذه الزائرة عن طريق سبر ما ظهر له من الصفات, فيضع أمامها مجموعة منوعة من الخيارات, فمن ناحية سلبها للعقول وتضليلها للأحداق, فيتوقع أنها قادمة من بلاد بابل في العراق, فهي لا تعدو أن تكون سحرا يغير النفوس ويعمي الأبصار, أم خمرا يغطي العقول بأكثف الأستار, وبالنظر إلى أبهتها في كسوتها وتاجها المزخرفين, إضافة إلى دهائها وذكائها الخارقين, فربما كانت قد نشأت تحت أفياء إحدى الحضارات القديمة, أوتربت في أحضان بعض الأسر الملكية العظيمة, إن لم تكن من بنات بعض الفرسان المعدودين, أو منتمية إلى واحد من البلغاء المشهورين. وكأن الشاعر في البيت الثاني يحاول محاصرة زائرته بين ثلاث خيارات لا رابع لها, فهي في النهاية إما أن تكون من بنات هؤلاء الملوك وكرائم هؤلاء الكرام, وإما أن تكون عنقودا من عناقيد الأعناب التي تعصر منها الخمور التي تنسب إلى تلك البلدان, وإلا فهي من بنات امرئ القيس أو غيره من الشعراء المشهورين بالبلاغة الساحرة. (وإلا, فأنتِ درةٌ صدفيةٌ... ثوتْ حِججاً مغموسةً في المغاطس) (فقالت: أبي تهذي؟ أبي, أو لم تكن... بأنسب نسَّابٍ وأفرس فارس) المفردات: درة: واحدة الدر, و هي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. صدفية: منسوبة إلى الصدف, صدف الدرة غشاؤها, وكل شيء مرتفع عظيم كالهدف و الحائط و الجبل و الناحية و الجانب فهو صدف. ثوت: ثوى بالمكان و فيه ثواء وثويا: أقام و استقر. حججا: بوزن عنب, جمع حجة, والحجة بالكسر: السنة. مغموسة: غمسه في الماء مقله فيه, ومَقَلهُ في الماء: غَوَّصَه فيه, يقال: غَمَست الثَّوبَ واليدَ في الماء، إذا غططتَه فيه. المغاطس: الغطس في الماء الغمس فيه, الغين والطاء والسين أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على الغَطِّ. يقال: غطَطْتُه في الماء وغَطَسته. أبي تهذي؟: أتهزأ بي: أتسخر بي؟ الهُزْءُ: السُّخْرية، يقال: هَزِيءَ به يَهْزأُ به، واسْتَهزأَ به، وتَهَزَّأَ به. أبي: والدي. أنسب نساب: أعلم بالأنساب, وأرق نسيبا, وأهدى إلى الصراط المستقيم, رجل نسابة أي عالم بالأنساب, والهاء للمبالغة في المدح, ونسبت الرجل ذكرت نسبه, النون والسين والباء كلمةٌ واحدة قياسُها اتِّصال شيءٍ بشيء. منه النّسَب، سمِّي لاتِّصاله وللاتِّصالِ به. تقول: نَسَبْتُ أنْسُِبُ. وهو نَسِيبُ فلانٍ. ومنه النَّسيبُ في الشِّعر إلى المرأة، كأنَّه ذِكْرٌ يتَّصِل بها؛ ولا يكون إلاَّ في النِّساءِ. تقول منه: نَسَبْتُ أنْسُِبُ. والنّسيبُ: الطريق المستقيم، لاتِّصال بعضِه من بعض, وبالمرأة نسبا ونسيبا ومنسبة شبب بها في الشعر. والنساب والنسابة العالم بالنسب. وهذا الشعر أنسب، أي أرق نسيبا. أفرس فارس: أعلم بالفراسة, أثبت نظرا, وأحذق بركوب الخيل, فارس: أي صاحب فرس, و الفراسة بالكسر الاسم من قولك تفرست فيه خيراً, وهو يتفرس أي يتثبت وينظر, تقول منه رجل فارس النظر وفي الحديث { اتقو فراسة المؤمن } و الفراسة بالفتح والفروسة والفروسية كلها مصدر قولك: رجل فارس على الخيل, وقد فرس من باب سهل وظرف أي حذق أمر الخيل, وأحكم ركوبها فهو فارس بالخيل, وفلان صار ذا رأي وعلم بالأمور فهو فارس بالأمر عالم بصير, وفرسَ السبعُ فريستَه، إذا حَطَمها. ويقال: فَرسْتُ عنقَ الشَّاة، إذا اعتمدتَ على الفِقْرة ففصلتَها مِن الأخرى, الفاء والراء والسين أُصَيل يدلُّ على وطءِ الشَّيء ودقِّه, وممكنٌ أن يكون الفَرَس من هذا القياسِ؛ لركلِهِ الأرضَ بقوائمه ووَطْئِه إيَّاها. المحتوى: يرخي الشاعر في هذا البيت ـ بسب إصرار من يحاورها على الصمت ـ للجواز العقلي زمامه, وكأن الشكوك تساوره في حقيقة هذا الشبح الماثل أمامه, فلم يعد بمقدوره ـ حسب ما يتظاهر به ـ التأكد من كون ما يقابله من الأجسام الناطقة أًصلا, فقد استعرض الممكنات الملائمات لمظهره فصلا فصلا, فنهاية سبره واستقرائه المستقصي وتقسيماته, تؤدي به إلى احتمال كون زائرته واحدة من الدر, بل من يتيماته, فبما أنها قد تحدت معرفته الواسعة المتجاوزة للحدود, فلتكن مع عظمتها وبهائها من الدرر العظيمة المعروفة بالركود, فلولا طول التزامها الاحتجاب بأعماق البحار, متلفعة بمروط أصدافها عن أعين النظار, لما طال التجوال مع نسابة بهذا الحجم في هذا المضمار, ويدرك الشاعر ما في العبارة من الاستهتار, والاتهام بالخفاء والاستتار, لكنها استفزاز تعمده كآخر خيار. وهذا الأسلوب الأخير بما يحمله من استثارة واستفزاز, وبما يوحي به من اتهام بالخرس قد يستشفه من يفهم المجاز, إضافة إلى ما يحمله من الرمي بالاختفاء عن الأنظار, عكس ما ترنو إليه الغواني من سعة السمعة والاشتهار, هو ما أجبر به الشاعر زائرته إلى الخروج من صمتها بالاستنكار, كما هو شأن العظماء عند الاضطرار للانتصار, فقد كانت من العظمة والاشتهار بالمحل اللائق والمقام المجزي, فلا محمل عندها للاستفسار عنها إلا أن يكون صادرا ممن يستهزي, إلا أنها لطفت خطابها وحمّلته تنبيها, وبررت إنكارها بأنها معجبة بالشاعر صنو أبيها, ولم لاتعجب به وهو المصدّر في معرفة النسيب والأنساب, والمستمسك بأزمتهما بإجماع من الشيوخ والشباب, مع ما برز فيه من صدق الفراسة وصوابها, إضافة إلى ولوجه الفروسية من أوسع أبوابها, بجانب استحواذه من الأساليب على كامل نصابها, ولا يمكن إيجاد مبرر لاستنكارها ألطف من إبداء إعجابها؟! (فقلت لها: سبحان منك! تنسَّبي... فقالت: ومنك, إنني بنتُ هاجس) المفردات: سبحان منك: العرب تقول: سبحان مِن كذا، أي ما أبعدَه, وسبحان الله, معناه: التنزيه لله, وهو نصب على المصدر, كأنه قال أبرئ الله من كل سوء براءة, والتَّنْزيه: التبعيد. تنسبي: عرفي بنفسك, اذكري نسبا ما, انتسب إلى أبيه، أي اعتزى. ومنك: أي وسبحان منك. هاجس: خاطر, هجس الأمر بالقلب هجساً وقع وخطر, فهو هاجس. المحتوى: في هذا البيت قد سيطر الإعجاب على الشاعر أيضاً تجاه الجواب المقتضب السابق؛ لما ينم به تعبير الزائرة من شخصية واثقة ومنطق صادق, واستغرب من تمنعها المشوب بالترغيب, وبتظاهرها بالتباعد عن التصريح عكس ما يحاوله من التقريب! فما كان من محاورته اللبيبة إلا أن حاكته في التعبير, وأوجزت في الخطاب كما هو أدب الصغير عند مخاطبة الكبير, وقامت بصرف الكلام إلى وجهة غير التي يترقبها المحاور, فأفصحت بأنها لم تكن إلا من بنات الخواطر. (فقلتُ لها: أي الهواجس؟ إنني... أراكِ ابنةَ الوضَّاح: خُس بن حابس) المفردات: الهواجس: الخواطر, جمع هاجس. أراكِ: أعلمك, الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد, وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين. الوضاح: الوضاح الرجل الحسن الوجه, وجَذِيمة الأبْرَش بن مالك بن فَهم الأزدي: بعض ملوك العرِب, الوضح: بياض الصبح والقمر والغرة والتحجيل في القوائم وغير ذلك من الألوان. خس بن حابس: الخس - بالضم - : اسم رجل، ومنه هند بنت الخس, من العماليق, الإيادية التي جاءت عنها الأمثال, وكانت معروفة بالفصاحة نقله ابن دريد, وقال: الخس اسم رجل من إياد معروف، وهو أبو ابنة الخس. وفي نوادر ابن الأعرابي: يقال فيه خس وخص - بالسين والصاد - ، وهو خس بن حابس بن قريط الإيادي. وقال أبو محمد الأسود: لا يجوز فيه إلا الخس - بالسين . المحتوى: ما كانت هذه المصارحة السابقة لتختطف الشاعر كما هو هدف زائرته, فالذي يحلو لذائقتها من الإيجاز والاختصار ليس متلائما مع ذائقته, فما يرضى أن يطفو على السطح ولا أن ينعتق من الإغراق, فلم يزل عنده من النفس ما يكفي لمواصلة السباحة في الأعماق, فها هو ذا لا يسمح بأن يعرج على الحقيقة ذلك التعريج, إذ لا مناص من الانتهاء إليها ولكن بالتدريج, فيتساءل ما إذا كان بالإمكان أن تتساقط هذه الدرر النفائس, من بين ثنايا فتاة سوى بنات السادة الأشاوس, فنراه يلجأ إلى الحدس بعيدا عن مدركات الحس, ليحكم على محاورته بأنها هند بنت الخس, فهي التي تضرب بفصاحتها الأمثال, كما كانت آباؤها من العمالقة الأقيال. (فقالت: لقد أعييتَني! فعِ أنتسبْ... فقلتُ لها: قولي, يع القولَ هاجس ي) (فقالت: نماني (ابنُ اليماني) ومن تطب... مغارسُه, يطبْ بطيب المغارس) المفردات: أعييتني: أفحمتني وأعجزتني, والعي ضد البيان, وقد عي في منطقه فهو عي, و عيي يعيا فهو عيي, ويقال أيضا عي بأمره و عيي إذا لم يهتد لوجهه, وأعياه أمره, والمعاياة أن تأتي بشيء لا يهتدى له. ع: احفظ, وعى الحديث يعيه وعيا: حفظه, وَوَعَى العَظْمُ: إذا انجَبَرَ بعدَ كَسْرٍ. واجسي: ذهني, الواجس: الهاجس = الخاطر, والواو والجيم والسين: كلمةٌ تدلُّ على إحساسٍ بشيءٍ وتسمُّعٍ له. تَوَجَّس الشَّيءَ: أحَسَّ به فتسمَّعَ له. نماني: نمى الرجل إلى أبيه نسبه, و انتمى هو: انتسب, ونميته: رفعته، وعزوته. ابن اليمان: هو الشيخ الشاعر (إغلس بن محمد بن اليمان), صاحب القصيدة التي يستجيب لها الشاعر. مغارسه: منابته, جمع مغرس, وهو موضع الغرس, غرس الشجر ونحوه غرسا: أثبته في الأرض. المحتوى: إلى هنا أدركت الزائرة الكريمة أن مجال جليسها في الخطابة رحب فسيح, وأنه لا ينوي أن يرفع عنها بالكنايات كلفة التصريح, فهي مضطرة إلى تقديم بطاقتها التعريفية وبكل توضيح, فاعترفت بالعجز عن مجاراة هذا البليغ الفصيح, في ميادين الاستعارة والكناية والتلميح, وطالبت بإعطائها الفرصة وإعارتها الأسماع, فقد آن لحقيقتها أن ينكشف عنها القناع, وكأن الشاعر المحاور قد رضي منها بهذا القدر, ولا يبدو أنه تفاجأ بالأمر, فتقبل عرضها بكل انفتاح ورحابة صدر, مبشرا بقدراته في حسن الإنصات وإتقانه لفن السماع, كما هو مقتضى عبقريته التي انعقد عليها الإجماع, فلم يكن ذهنه إلا عبارة عن وعاء مهيأ للاحتفاظ بما يوضع فيه من معلومات, وليست خواطره إلا أداة استقبال جاهزة لالتقاط أدق المسموعات. ثم فسحت الزائرة المجال للشاعر في استخدام ذكائه ومهارته في علم الأنساب, فاكتفت عن الانتساب إلى أبيها بالانتماء لجدها وعن الأسماء بالألقاب؛ وبما أن الشاعر خبير مبرز في هذا المجال, فقد اكتفى منها بهذا الاختصار والإجمال, ففهم كل ما لمسه من سحرية وجمال, وعلم أنها الخمر لكنها من النوع الحلال, فما أطيب جذعا انبثقت منه شماريخها, وما أجمل تاريخا هو تاريخها, فقد ارتفعت إلى المقام الأجل الأسمى, وذكرت شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. 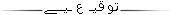
قال الإمام العارف ابن قيم الجوزية -رحمه الله : كل علم أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام خرج من مشكاة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الصراط المستقيم وما لم يكن كذلك فهو من صراط أهل الغضب والضلال ).
|
|
|
#2 |
|
عضو مؤسس
 |
في المقطع الآتي يخلد الشاعر للتاريخ لوحة بريشته المبدعة لوحة فنية تتضمن بعض ملامح شخصية والد زائرته الكريمة/ الشيخ الشاعر (إغلس) فيقول:
فتىً, كلما قرَّتْ على الرَّق كفُّه = أقرَّ له بالرِّقِّ كلُّ مُمارس وإن شاء إنشاءَ القوافي, شأَى بها = بمضمار سبقٍ كلَّ قَِرن مُنافس أو استبقت فرسانُ علمِ بلاغةٍ = بميدانها استتْلى بها كلَّ فارس إذا ما تحرَّى القولَ يوماً, فثِقْ به = ولا تبحثنْ عمَّا تحرى ابنُ عابس لقد أُنشِئتْ في راحتيه, فرِدْهما = سحائبُ عشرٌ, كم جلَت بُؤسَ بائس يسحُّ بتا قطرُ الندى, وبتا الرَّدى = على الوِدِّ والضِّدِّ المعادي المُغامس هُما فاعتبر, كاسميهما, فادرِ ما هما = إذا اغبرَّتِ الآفاقُ في فصل مارس فيُمناه يُمنُنا, ويُسراه يُسرُنا = وإن تكنِ الشُّؤمى فشؤمُ المُداعس لئن دلَّ عن رُشدٍ, وحضَّ مُحرِّضاً = على الدرس والتدريس, غيرَ مُدالس فلا بِدعَ, فهْو البدرُ, والجهلُ حِندِسٌ = وفي البدر تِمّاً جَلوةٌ للحنادس تبسيط المقطع السابق: (فتىً, كلما قرت على الرَّق كفُّه = أقرَّ له بالرِّق كلُّ ممارس) المفردات: فتى: الفتى الشاب القوي الحدث, و الفتاة الشابة وقد فتي بالكسر فتاء بالفتح والمد, والفتى أيضا السخي الكريم, يقال: هو فتى بين الفتوة, والجمع فتية وفتيان, واشتقاق الفتوى من الفتاء؛ لأنها جواب في حادثة أو إحداث حكم أو تقوية لبيان مشكل. كلما: كلمة تكرار وتعميم تستعمل ظرف زمان, (كل)يفيد التكرار والتعميم, إذا لحقتها (ما). قرت: ثبتت, وسكنت, قررت بالمكان بالكسر, أقر قرارا, وقررت أيضا بالفتح أقر قرارا وقرورا, والقر: صب الماء دفعة واحدة, وقرت الدجاجة صوتها, إذا قطعته, يقال: قرت تقر قرا وقريرا, فإن رددته قلت: قرقرت قرقرة, وقر الكلام والحديث في أذنه يقره قرا: فرغه وصبه فيها, وقيل: هو إذا ساره, ابن الأعرابي: القر: ترديدك الكلام في أذن الأبكم حتى يفهمه. الرَّق: الرق بالفتح ويكسر: ما يكتب فيه وهو جلد رقيق, أو الصحيفة البيضاء, والرَّقُّ: من دواب الماء شبه التمساح, والرَّقُّ أيضا: كل أرض إلى جانب وادٍ ينبسط عليها الماء أيام المد، ثم ينحسر عنها الماء فتكون مكرمة للنبات. كفه: الكف واحدة الأكف, وكف الخياط الثوب: خاطه مرة ثانية. أقرَّ: أقر بالحق اعترف به, والإقرا: ضدُّ الجحود, وأقرّ الله عينه: أي أعطاه حتى تَقِرَّ عينُه فلا تطمَحَ إلى من هو فوقه. الرِّق: الرق بالكسر من الملك وهو العبودية, ورق العبد رقا: صار أو بقي رقيقا, وأصل الرق من الرقة التي بمعنى الضعف, والرَّق والرِّق, والرَّقَق: ضعفٌ في العِظام, ويقال للأرض اللينة: رق. ممارس: معالج للقريض ومزاول للكتابة, (مجاور في (مَرْسِ) واحة من واحات (أزواد), مَرَسْتُ الشيءَ أمرُسه مَرْساً، إذا دَلَكْتَه. ورجل مَرِسٌ وممارِس: صبور على مِراس الأمور. ورجل ممارس للأمور: معالج ومزاول لها. المحتوى: كان الشاعر أثناء محاورته لزائرته يداري عاطفتها ويحابيها, لكنه ذهل عنها بعدما وصل من خلال الحوار إلى معرفة أبيها, فأطلق العنان لمشاعره تجاه هذا الشاب الجامع لمعاني الفتوة والكمال, القوي الحدث العابد المتفقه الكريم الخصال, من اعتادت إبداعاته استرقاق ألباب المهرة الكتاب, والتحكم في نواصي المحترفين المتمرسين في صياغة الخطاب, من تنساب ينابيع البلاغة من بين بنانه كالماء الرقراق, فتنسكب متصببة إلى قنوات جداول الأرواق, ليعترف له البارعون له بالإجادة والإتقان, بدءاً من مشاركيه في سكنى واحة (مَرْسِ) ووصولاً إلى كل مكان. (وإن شاء إنشاءَ القوافي, شأى بها... بمضمار سبقٍ كلَّ قَِرنٍ منافس) المفردات: شاء: أراد, المشيئة الإرادة, تقول: شاء يشاء مشيئة, وقيل: إنها أخص من الإرادة إنشاء: مصدر أنشأ: إذا أنشد شعرا أو خطب خطبة فأحسن فيهما, وأنشاني الطيب والعطر إنشاء أشمني إياه. القوافي: القصائد, قوافي الشعر, والكلام المقفى من قولهم: قفا أثره: اتبعه؛لأن بعضها يتبع أثر بعض, وقافية الرأس: هي القفا, وقافية كل شيء آخره, وفي مصطلح العروضيين: الحروف التي تبدأ بمتحرك يليه آخر ساكنين في آخر البيت. شأى: شأوت القوم، أي: سبقتهم، أشأى شأواً, و شأى الشيء فلانا أعجبه و شاقه وأحزنه. مضمار سبق: الموضع الذي تضمر فيه الخيل, وقد يكون المضمار وقتاً للأيام التي تُضمَّر فيها الخيل للسباق أو للرَّكض إلى العدو، وتضميرها أن تُشدّ عليها سُروجُها، وتُجلَّل بالأجلة حتى تعرق تحتها, فيذهب رهلها ويشتد لحمها، ويُحمل عليها غلمان خفاف يجرونها البردين ولا يعنفون بها، فإذا ضُمِّرت واشتدت لحومها, أُمن عليها القطع عند حُضرها, ولم يقطعها الشَّدُّ، فذلك التَّضمير الذي تعرفه العرب، ويُسمونه مِضمارً وتضميراً. قِرن: بفتح القاف مثلك في السن, فلان قَرن فلان, إذا كان من لداته, وبكسرها مثلك في الشجاعة, فلان قِرن فلان, إذا كان يقاومه في بطش أو قتال. منافس: مجار ومبار في مضمار الشعر, نافس في الشيء منافسة و نفاسا بالكسر, إذا رغب فيه على وجه المباراة في الكرم, و تنافسوا فيه, أي رغبوا, أو مسابق في النفاسة وهي الرفعة. المحتوى: ما زال الشاعر مندفعاً في تصفح صفات والد زائرته, وما فتئ يعرض صوراً مشوقة مما احتفظ به عن هذه الشخصية في ذاكرته, والمقام يستدعي التركيز على الجانب الأدبي من شخصية الممدوح بالأحرى, رغم أن بقية الصفات الكمالية ستتلاحق في شريط ذاكرته تترى, فما الشيخ (إغلس) في نظر الشاعر إلا سيد القوافي وأميرها, وما الذي يتموج في بحره إلا زلال البلاغة ونميرها, فهو الذي إذا رغب في صياغة القوافي أجاد وأطرب, وعطر مسامع النقاد بغوالي المسك أو أطيب, فهو المبرز السباق كلما جال بحصانه في الميدان, وإن كان الفرسان المتسابقون من المنافسين ومن الأقران. (أو استبقتْ فرسانُ علمِ بلاغةٍ... بمَيدانها, استتْلى بها كلَّ فارس) المفردات: استبقت: استبق الفارسان على فرسيهما إلى غاية: تسابقا إليها. فُرسان: جمع فارس. علم بلاغة: هو العلم بالقواعد التي بها يعرف أداء جميع التراكيب حقها, وإيراد أنواع الشبيه والمجاز والكناية على وجهها, وإيداع المحسنات بلا كلفة مع فصاحة الكلام. والغايةُ منه: تأديةُ المعنى الجميل واضحاً بعبارةٍ صحيحة فصيحةٍ، لها في النفس أثرٌ ساحر، مع ملاءمة كلِّ كلامٍ للموطنِ الذي يقال فيه، والأشخاصُ الذين يُخاطَبون, وعناصرُه: لفظٌ ومعنًى، وتأليفٌ للألفاظ يمنحُها قوةً وتأثيراً وحسناً، ثم دقةٌ في اختيار الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه، وموضوعاته، وحال السامعين، والنزعةِ النفسية التي تتملكهم، و تسيطرُ على نفوسهم. وينقسمُ هذا العلمُ ثلاثة أقسامٍ: علمُ المعاني : وهو علمٌ يعرَفُ به أحوال اللفظ العربيِّ التي بها يطابقُ مقتضَى الحال. علمُ البيان: وهو علمٌ يعرَف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة ٍفي وضوحِ الدلالة عليه. علمُ البديع: وهو علمٌ يعرَف به وجوه تحسين الكلام، بعد رعايةِ تطبيقه على مقتضَى الحال ووضوحِ الدلالة. ميدان: فسحة من الأرض متسعة معدة للسباق أو للرياضة ونحوها, يقال: ميدان السباق وميدان الكرة وميدان الحرب. استتلى: تلا تلوا: اتبع وتخلف, وفلاناً تبعه في عمله, واستتلى: استتبع, أوجعله تالياً, أي: تابعاً, أوجعله يأتي تالياً, أي: في المركز الرابع من خيل الحلبة,. وأولها المجلي: وهو السابق والمبرز, ثم المصلي: وهو الثاني, ثم المسلي: وهو الثالث, ثم التالي: وهو الرابع, ثم المرتاح: وهو الخامس, ثم العاطف: وهو السادس, ثم الحظي: وهو السابع, ثم المؤمل: وهو الثامن, ثم اللطيم: وهو التاسع, ثم السكيت: وهو العاشر, والمحفوظ عن العرب: السابق، والمصلي، والسكيت الذي هو العاشر, فأما باقي الأسماء فقال اللواتي الأجدابي: أراها محدثة. فارس: سبقت معانيها. (إذا ما تحرَّى القولَ يوماً, فثِقْ بهِ... ولا تبحثَنْ عما تحرَّى ابنُ عابس) المفردات: تحرى: قصد وتوخى واختار. ثق: وثق به يثق ثقة: إذا ائتمنه, وَثِقْتُ بفلان أثق به ثِقةً وأنا واثِقٌ به، وهو مَوْثُوقٌ به. ابن عابس: امرؤ القيس بن عابس شاعر جاهلي أدرك الإسلام, والعابس: الكالح المقطب ما بين عينيه, والأسد الذي تهرب منه الأسود. المحتوى: في هذا البيت وطائفة من الأبيات التي تليه, يواصل شاعرنا اقتطاف أطايب مدحه وأعاليه, ليقدمها كأسا حلالاً لوالد زائرته النبيه, وإنما يُعرف الفضل لذي الفضل عند ذويه, فها هو ذا يرسخ قناعته باستحواذ صاحب العينية على أزمة البيان, واستحقاقه التقدم على أصحاب الفراسة والفرسان, واستتباعه لخيل الحلبة عند مباراته لهم في الميدان, فهو الثقة الذي يؤخذ بأقواله في الصياغة والنقد بكل اطمئنان, فلا يقدم اختيار غيره على اختياره, ولو كان معدودا من العرب الخلصان. (لقد أُنشئتْ في راحتيه فرِدْهما... سحائبُ عشرٌ, كم جلتْ بؤسَ بائس) المفردات: أنشئت: مبني للمجهول, من قولهم: نشأت السحابة: ارتفعت. راحتيه: كفيه, الراحة: الكف, والساحة. رِد: الورد: ضد الصدر, ورد يرد بالكسر ورودا: حضر. سحائب: جمع سحابة, وهي الغيم, والسحب: جر الشيء على وجه الأرض, كسحب الريح التراب. وسمي السحاب سحابا؛ لانسحابه في الهواء. جلت: كشفت, وأذهبت, جَلَوت عنيِّ همِّي جلوا، إذا أذهبته, والجيم واللام والحرف المعتل أصلٌ واحد، وقياسٌ مطّرد، وهو انكشاف الشيء وبروزُه. بؤس: الفقر, ضدّ النعيم. بائس: شديد الحاجة, بئس الرجل يبأس بؤسا: اشتدت حاجته, فهو بائس. (يسحُّ بتا قطرُ الندى, وبتا الرَّدى... على الوِد والضدّ المعادي المغامس) المفردات: يسح: ينصبُّ, سَحَّ المَطَرُ والدَّمْعُ يَسِحُّ سَحّاً اشتد انصبابه. تا: إشارة إلى كف الممدوح اليمنى, وتا: اسم يشار به إلى المؤنث. قطر: القطر: المطر. الندى: السخاء والجود وبعد ذهاب الصوت والمطر والبلل. الردى: الهلاك والسقوط. الود: الود والوديد: الخل والصديق والمحبوب, وددت الرجل بالكسر ودا بالضم: أحببته. الضد: المخالف, والمثل, من ذوات الأضداد, وكل شيء خالفك ليغلبك فهو ضد. المعادي: المبغض المشاحن, الذي يبادلك العداء, والعداء بالفتح والمد: تجاوز الحد في الظلم. المغامس: المغامسة: المغاطة في الماء, والمباراة في ركوب الخطوب, والمغامِسة أيضا: الطعنة النافذة. (هُما ـ فاعتبر ـ كاسميهما, فادرِ ما هما... إذا اغبرَّت الآفاقُ في فصل مارس) المفردات: هما: ضمير راجع إلى راحتي الممدوح. فاعتبر: قايِس, وتعجَّب, الاعتبار: القياس, واعتبر منه : تعجب. كاسميهما: اليُمن من اليمنى والشُّؤم من الشؤمى. ادرما هما: اعلم حقيقتهما. اغبرت: تلبدت بالغبار, اغبر الشيء اغبرارا إذا تلبد بالغبار. يقال لسنة المجاعة: غَبْراء ويقال: جوعٌ أغْبَر؛ وذلك لأنهم يقولون: إن الجائع كان يرى بينه وبين السماء دُخاناً من شِدَّة الجوع, أو ليبْسِ الأرض في الْجدْب وارتفاع الغُبار. الآفاق: النواحي, ومفردها أفق. والهمزة والفاء والقاف أصل واحد، يدلّ على تباعُد ما بين أطراف الشيء واتساعِه، وعلى بلوغ النهاية, ومن ذلك الآفاق: النواحي والأطراف, وللسماء آفاق وللأرض آفاق, فأما آفاق السماء: فهي ما انتهى إليه البصر منها مع وجه الأرض من جميع نواحيها، وهو الحدُّ بين ما بَطَن من الفَلَك وبين ما ظَهَر من الأرض, وأما آفاق الأرض, فأطرافها من حيث أحاطت بك. فصل مارس: الشهر الثالث من الشهور الرومية, وإله الحرب في الأساطير, وهو المريخ, ويقابله شهر آذار من الشهور السريانية. (فيمناه يمُننا, ويُسراه يُسرُنا... وإن تكن الشؤمى, فشُؤم المُداعس) المفردات: يمنى: اليد اليمنى (اليمين). يمننا: بركة لنا. يسرى: اليد اليسرى, اليسرى واليسرة والميسرة: خلاف اليمنى واليمنة والميمنة. وتسمى عسرى؛ لأنها يتعسر عليها ما لا يتعسر على اليمنى, وتسمى يسرى على طريقة التفاؤل. يسر: اليسر السعة والغنى, خلاف العسر. شؤمى: اليد الشؤمى: ضد اليمنى شؤم: والشؤم: ضد اليُمن. المداعس: المطاعن المدافع, والمداعَسَة: المطاعَنَة. (لئن دلَّ عن رُشدٍ, وحضَّ محرِّضاً... على الدرسِ والتدريسِ غيرَ مُدالس) المفردات: دل: دله على الطريق: هداه, وأصل الدلالة إبانة الشيء بعلامة تتعلمها. رشد: الاستقامة والهداية, الرشد والرشاد: ضد الغي و الضلال, ومنه (يقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد). حض: بعث ورغب, الحض: البعث على الشيء والترغيب فيه, وحَضَضْتُ الرجلَ على الشيء أحُضُّه حَضًّا، أي حرَّضته. محرضا: التحريض الحث على الشيء, والتنشيط إليه والإحماء عليه. الدرس: دَرْسُ الكتابِ للحِفْظ، ودَرَسَ دِراسةً، ودارَسْتُ فلاناً كتاباً لكي أحفَظَ. التدريس: نشر العلم. مدالس: المخادع, دالسه خادعه, من التدليس, وهو كتمان العيب. (فلا بِدعَ, فهْو البدرُ, والجهلُ حِندسٌ... وفي البدر تِمّاً جَلوةٌ للحنادس) المفردات: لا بِدع: لا غرابة, ويقال: فلان بدع في هذا الأمر، أي أول لم يسبقه أحد, ويقال: ما هو ببديع ، كما يقال: ببدع. البدر: القمر, قيل: سمي بذلك لمبادرته الشمس بالطلوع, وقيل: لتمامه, والباء والدال والراء، أصلان: أحدهما كمال الشيء وامتلاؤه، والآخر الإسراع إلى الشيء. الجهل: ضد العلم, أو انتفاؤه, أو تصوير الأمر بخلاف ما هو عليه. حندس: الحِنْدِسُ: الظُّلْمة, أو الليل الشديد الظلمة.. التِّم: بدر التم والتمام: إذا كان لأربع عشرة ليلة. جلوة: جلا الضياء الظلمة كشفها وأزالها, والسماء جَلْواءُ أي مُصْحِية. ويقال: تجلَّى الشيءُ، إذا انكشَفَ. الحنادس: الظلمات, أو ثلاث ليال في آخر الشهر، لظلمتهن. لقد أنشئت في راحتيه فرِدهما... سحائبُ عشر كم جلت بؤس بائس يسح بتا قطرُ الندى, وبتا الردى... على الود والضد المعادي المغامس هما ـ فاعتبر ـ كاسميهما, فادر ما هما... إذا اغبرت الآفاق في فصل مارس فيمناه يمننا, ويسراه يسرنا... وإن تكن الشؤمى, فشؤم المداعس المحتوى: لم يكن الشاعر (إغلس) ممن اكتفى بالأقوال عن الأفعال, بل كانت شخصيته نموذجا من نماذج كملة الرجال, فهو مع تربعه في بحبوحة البلغاء وفرسان القلم, تمثال للجواد الذي تزري كفه السحاء بهواطل الديم, فما أصابعه العشر إلا سحائب نشأت في سماء كفيه, وما شأنها إلا الانهمال على العافين عند اهتزاز عطفيه, فمين يمينه تنصب الخيرات والبركات على الشاعر وأمثاله من الموالين, ومن شماله تتهاوى صواعق الدمار على أضداده المعادين, فراحتاه لمعناهما من لفظهما نصيب, فما هما للكاشح والمعادي المريب, إلا الهلاك المدمر لكل من يصيب, بينما تمثلان الراحة والبركة لكل حبيب, لا سيما عند نزول الخطب العصيب, فيمينه رمز ليمن يعم الأصدقاء والأحباب, ويسراه كفيلة بطرد العسر من جميع الأبواب, وإن سميت بالشؤمى فهي التي تصب على المعادين سوط العذاب. لئن دل عن رشد وحض محرضا... على الدرس والتدريس غير مدالس فلا بدع, فهو البدر والجهل حندس... وفي البدر تِمّاً جلوة للحنادس المحتوى: في هذين البيتين يؤكد الشاعر قبوله لنصيحة أخيه, فيستدل لاستحقاقه منصب الإرشاد ويزكيه, فليس الشاعر إغلس في نظره إلا البدر في ليلة التمام, وما الجهل الذي ينعاه إلا غشاء من سدف الظلام, فما أحراه بأن يسرع إلى إضاءة أفقه بالحث على التعليم, وما أبعده عن التدليس أو التعتيم, فمثله يستحق القيام بالهداية للرشاد, ويجب عليه القيام بمسؤوليته في تنوير موقعه من البلاد, فلا غرابة حينما يقوم بمزاولة مثل هذه المهمات, كما لا غرابة حينما يطلع القمر فتنكشف الظلمات. |

|
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| روايات من روائع الأدب العالمي | عبادي السوقي | منتدى المكتبات والدروس | 20 | 09-24-2016 07:18 PM |
| قصة العبودية في كتب المالكية ,, | عبادي السوقي | المنتدى الإسلامي | 4 | 08-30-2012 05:03 PM |
| النص الشرعي : مفهومه و فهمه | تغارجيه | منتدى المصطلحات | 3 | 07-21-2012 12:16 AM |