|
||||||
| المنتدى التاريخي منتدى يهتم بتاريخ إقليم أزواد . |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
|
محمد يحظيه ولد ابريد الليل يكتب : موريتانيا وازواد “1″
بدأ الكاتب المخضرم الجزء الأول من السلسلة التي عنوانها ب “موريتانيا وأزواد” بالحديث عن التغلغل الاستعماري في موريتانيا، وكيف أن كابولاني حاول أن يحتل موريتانيا من خلال إقليم أزواد، وعجز عن تنفيذ خطته هذه بسبب عدم القدرة على تأمين خطوط اتصال. أو طرق إمداد فاختار الطريق الأسلم من خلال الجارة السنغال التي يحتلها الفرنسيون آن ذاك منذ ما يقرب من قرن. كما عرج الكاتب في هذه الأثناء على الجهود الكبيرة التي بذلها الشيخ ماء العينين بالتعاون مع ملوك المغرب في سبيل صد التغلغل الاستعماري. وتحدث بعد ذلك عن خطة كابولاني في التغلغل السلمي في البلد من خلال الاستيلاء على عقول وقلوب قادة الرأي في البلد، والتأكيد باستمرار على عدم عداوة فرنسا للإسلام، وتدليلا على ذلك “قام بتوزيع عدد من كتب المتصوفة مثل دليل الخيرات وكتب الجزولي وغيرها” حسب تعبير الكاتب وانتقد ولد ابريد الليل بعد ذلك بشدة تجاهل قادة البلد على مدى الخمسين عاما لمنطقة أزواد التي يري السياسي المعروف أنها تجتمع مع البلد في عدد كبير من الأمور، وأرجع جزء كبيرا من ذلك إلى أن قادة البلد لم يكونوا يستشيرون أحدا في رسم سياساتهم بل يرون أن مثل هذه الاستشارة تنقص من قدر الرئيس. ولم يثر اهتمامنا لهذه المنطقة المهمة لنا إلا ما حدث من أحداث في الآونة الأخيرة، فأصبحنا فجأة ندرك أن هناك جارا لنا اسمه أزواد، كما لو أنه هناك جدار سميك يمنعنا من التواصل مع هذه المنطقة. وتوقف الكاتب عند ما تعرضت له هذه المنطقة خلال الخمسين سنة هي عمر الدولة الموريتانية من ظلم وضغوط “دون أن يثيرنا ذلك” حسب تعبير الكاتب مرجعا ذلك إلى أنه قد تكون هناك أشياء حدثت في مناطق أقرب منعتنا من سماع ما يحدث هناك. ولد ابريد الليل أسقط نفس الوضع على الصحراء الغربية التي اعتبر أن الدولة تجاهلتها طويلا أكثر من 18 سنة من الاستقلال، قبل أن تقيم فيها ما وصفها ب “مسرحية هزلية أعاقتنا عن الاهتمام بهذا الجزء من الإقليم” ودلل الكاتب على ذلك بما وصفها ب”الحركة التي قام بها عدد من الصحراويين والموريتانيين في العام 1970من القرن الماضي من أجل التوعية بضرورة استقلال الصحراء عن إسبانيا، لكن هذه الحركة لقيت كل التجاهل من الحكومة الموريتانية حتى قتل رئيسها تحت التعذيب من قبل الإسبان دون أن تنبس حكومتنا ببنت شفة، بل أكثر من ذلك تعرضت مظاهرات هذه الحركة في انواكشوط إلى القمع من قبل الشرطة الموريتانية” حسب تعبيره وأضاف الكاتب “ولو فرضنا أن ما بذلته الحكومة الموريتانية من جهد ومال ورجال في حرب الصحراء ذهب جزء قليل منه إلى العمل في ذلك الوقت من أجل جلاء الاستعمار الإسباني لكان الوضع مختلفا تماما الآن، وخصوصا على المستوى الأخلاقي” ويضيف ولد ابريد الليل “لقد كانت سياسة موريتانيا تجاه الصحراء بعيدة كل البعد عن الاتجاه الصحيح، وهو ما أدى بنا في النهاية إلى أن ندخل في متاهة لن نخرج منها أبدا” وبرر ولد ابريد الليل-وهو للتذكير أحد قادة الجناح المدني لانقلاب العاشر من يوليو- ماقام به قادة هذا الانقلاب من انسحاب من نزاع الصحراء بأنه كان ضروريا لوقف حمام الدم، ومع ذلك فإنه لم يصلح ما فسد من قبل، فقد اتسع الخرق على الراقع، فقد انقطعت أواصر الأخوة بيننا” حسب تعبيره وختم ولد ابريد الليل الحلقة الأولى من السلسلة بقوله “إن من أسسوا بناء الدولة وضعوا قاعدة تقول: القضايا الخطيرة أولى من القضايا الكبيرة، فليس علينا أن نناقش مستقبلنا البعيد وأن نضع الرؤي السياسية له، فكل هذه الأمور موكولة إلى القائد المتفرد، وكل من جاءوا إلى الحكم كانوا يقومون بإطفاء الحرائق المشتعلة لا أكثر، ويجرون وراءهم تقاليد موروثة، ومساعدين لمن قبلهم لا يزالون حاضرين في المشهد، ويتبعون سياسة أن الصمت أبلغ من الكلام”. **************** موريتانيا وأزواد/بقلم: محمد يحظيه ولد ابريد الليل (الحلقة الثانية) الثلاثاء, 14 أغسطس 2012 22:28محمد يحظيه ولد ابريد الليل يكتب : موريتانيا وازواد “1″ كتبت منذ 6 أيام مضت | 0 تعليق بدأ الكاتب المخضرم الجزء الأول من السلسلة التي عنوانها ب “موريتانيا وأزواد” بالحديث عن التغلغل الاستعماري في موريتانيا، وكيف أن كابولاني حاول أن يحتل موريتانيا من خلال إقليم أزواد، وعجز عن تنفيذ خطته هذه بسبب عدم القدرة على تأمين خطوط اتصال. أو طرق إمداد فاختار الطريق الأسلم من خلال الجارة السنغال التي يحتلها الفرنسيون آن ذاك منذ ما يقرب من قرن. كما عرج الكاتب في هذه الأثناء على الجهود الكبيرة التي بذلها الشيخ ماء العينين بالتعاون مع ملوك المغرب في سبيل صد التغلغل الاستعماري. وتحدث بعد ذلك عن خطة كابولاني في التغلغل السلمي في البلد من خلال الاستيلاء على عقول وقلوب قادة الرأي في البلد، والتأكيد باستمرار على عدم عداوة فرنسا للإسلام، وتدليلا على ذلك “قام بتوزيع عدد من كتب المتصوفة مثل دليل الخيرات وكتب الجزولي وغيرها” حسب تعبير الكاتب وانتقد ولد ابريد الليل بعد ذلك بشدة تجاهل قادة البلد على مدى الخمسين عاما لمنطقة أزواد التي يري السياسي المعروف أنها تجتمع مع البلد في عدد كبير من الأمور، وأرجع جزء كبيرا من ذلك إلى أن قادة البلد لم يكونوا يستشيرون أحدا في رسم سياساتهم بل يرون أن مثل هذه الاستشارة تنقص من قدر الرئيس. ولم يثر اهتمامنا لهذه المنطقة المهمة لنا إلا ما حدث من أحداث في الآونة الأخيرة، فأصبحنا فجأة ندرك أن هناك جارا لنا اسمه أزواد، كما لو أنه هناك جدار سميك يمنعنا من التواصل مع هذه المنطقة. وتوقف الكاتب عند ما تعرضت له هذه المنطقة خلال الخمسين سنة هي عمر الدولة الموريتانية من ظلم وضغوط “دون أن يثيرنا ذلك” حسب تعبير الكاتب مرجعا ذلك إلى أنه قد تكون هناك أشياء حدثت في مناطق أقرب منعتنا من سماع ما يحدث هناك. ولد ابريد الليل أسقط نفس الوضع على الصحراء الغربية التي اعتبر أن الدولة تجاهلتها طويلا أكثر من 18 سنة من الاستقلال، قبل أن تقيم فيها ما وصفها ب “مسرحية هزلية أعاقتنا عن الاهتمام بهذا الجزء من الإقليم” ودلل الكاتب على ذلك بما وصفها ب”الحركة التي قام بها عدد من الصحراويين والموريتانيين في العام 1970من القرن الماضي من أجل التوعية بضرورة استقلال الصحراء عن إسبانيا، لكن هذه الحركة لقيت كل التجاهل من الحكومة الموريتانية حتى قتل رئيسها تحت التعذيب من قبل الإسبان دون أن تنبس حكومتنا ببنت شفة، بل أكثر من ذلك تعرضت مظاهرات هذه الحركة في انواكشوط إلى القمع من قبل الشرطة الموريتانية” حسب تعبيره وأضاف الكاتب “ولو فرضنا أن ما بذلته الحكومة الموريتانية من جهد ومال ورجال في حرب الصحراء ذهب جزء قليل منه إلى العمل في ذلك الوقت من أجل جلاء الاستعمار الإسباني لكان الوضع مختلفا تماما الآن، وخصوصا على المستوى الأخلاقي” ويضيف ولد ابريد الليل “لقد كانت سياسة موريتانيا تجاه الصحراء بعيدة كل البعد عن الاتجاه الصحيح، وهو ما أدى بنا في النهاية إلى أن ندخل في متاهة لن نخرج منها أبدا” وبرر ولد ابريد الليل-وهو للتذكير أحد قادة الجناح المدني لانقلاب العاشر من يوليو- ماقام به قادة هذا الانقلاب من انسحاب من نزاع الصحراء بأنه كان ضروريا لوقف حمام الدم، ومع ذلك فإنه لم يصلح ما فسد من قبل، فقد اتسع الخرق على الراقع، فقد انقطعت أواصر الأخوة بيننا” حسب تعبيره وختم ولد ابريد الليل الحلقة الأولى من السلسلة بقوله “إن من أسسوا بناء الدولة وضعوا قاعدة تقول: القضايا الخطيرة أولى من القضايا الكبيرة، فليس علينا أن نناقش مستقبلنا البعيد وأن نضع الرؤي السياسية له، فكل هذه الأمور موكولة إلى القائد المتفرد، وكل من جاءوا إلى الحكم كانوا يقومون بإطفاء الحرائق المشتعلة لا أكثر، ويجرون وراءهم تقاليد موروثة، ومساعدين لمن قبلهم لا يزالون حاضرين في المشهد، ويتبعون سياسة أن الصمت أبلغ من الكلام”. موريتانيا وأزواد/بقلم: محمد يحظيه ولد ابريد الليل (الحلقة الثانية) الثلاثاء, 14 أغسطس 2012 22:28 altالذين يصرخون على أي حال، "الكياسة هبة الطبيعة"، كما يقول باسكال. لقد كان الاعتقاد سائدا إلى وقت قريب، بأن أول واجبات رجل السياسة، معرفة ضرورة الاعتدال، وأن يرسم لنفسه حدودا فليس كل من وجد أمامه مكبرا للصوت، أو حاز مأمورية انتخابية وتمتع بحصانة قانونية، أو انعدم لديه الخوف من الإلقاء في السجن بضع سنين، كما كان يحدث في الفترات الماضية.. عليه أن يتفوه بكل مكبوتاته من الشتائم والسّباب. التهتّـك جعل البعض يصرخون في مكبرات الصوت، مع العلم أنها لم تخترع إلا لتغني عن ذلك الصراخ، إن الحجة، أي الفكرة التي تهدف إلى الإقناع، غنية عن الصراخ، لأنها موجهة للعقول لا إلى الآذان. رجل الصراخ لا يوثق به. من يقذف بكل ما يجيش في نفسه من جيد أو ردئ لم يخلق للسياسة. فضلا عن ذلك هل كل ما ليس محرما هو مباح؟ كان الشيخ آمادو مؤسس امبراطورية ماسينا الفلاَّنية رجلا ورعا مستقيما، زاهدا. وكان يَسُوس دولته بواسطة مجلس علمي من ستين فقيها يحيطون به بصفة دائمة ويقررون كل شيء، كانوا متشددين حَرْفيين يقلدون نظام المدينة المنورة أيام الخلفاء الأولين. بالنسبة لهم الأمور بسيطة إما محرمة أو مباحة. لقد قال رينيه كاييه المعروف في مجتمعنا بـ"ولد كيج" الذي جاب الساحل وعبر الصحراء، حوالي 1824-1828 "إن الفلان أشد تعصبا من البيضان". للشيخ آمادو -إضافة إلى ما ذكرنا- ميزة أخرى هي الذكاء. كان يعرف أن الأمور ليست بالبساطة التي يراها الفقهاء. ولكي يفتح أعينهم أمر يوما بإعداد مائدة من اللحم أضاف إليها لحم الضب والجراد وحشرات أخرى. ودعاهم للأكل، فقالوا إنهم لا يأكلون مثل هذه اللحوم. فقال الشيخ إن الشرع لا يحرم أكلها!. فقالوا: نعلم ذلك! فقال: "إذن هناك أشياء لا يحرمها الشرع ومع ذلك يتعين علينا تركها.. وهذا ماعلينا أخذه في الحسبان مستقبلا". إن السياسة - من حيث هي رسالة - من أسمى وأجزل ما أنتجه البشر. صحيح أن الفلسفة تحوم فوقها، إلا أنهما تلتقيان عند مستوى معين. لأنه، "في السياسة، تتلخص الفلسفة" كما يقول اغرامشي. ويذهب ماركيز، أبعد من ذلك ويعكسه قائلا: " إن دور السياسة هو تحليل مضامين المفاهيم الفلسفية، للوصول إلى حقيقة غير مشوهة". إنها إنسانوية النهضة الأوروبية التي جاءت بهذا الربط الرائع، جاعلة من الإنسان قيمة عليا. أما الأيديولوجيا، فجاءت بعد ذلك بكثير، من أجل إضفاء التماسك والانسجام على المبادئ السياسية، وربط الوسائل بالغايات وجعلهما أكثر تطابقا. كثيرا ما يوردون علم الاقتصاد إلى جانب السياسة. إن ذلك خال من المعنى. إن الاقتصاد هو خادم للنظام الاجتماعي السائد. القانون هو الآخر مجرد خادم بسيط لذلك النظام. أما السياسة، فهي ساحرة. مكانُها سماء المعارف، في تلك المجرة حيث الشعر وربما السحر، لا لقيمة الأخيرين وقدرهما، وإنما لاستقلاليتهما واستبدادهما. أي جامعة تمنح شهادات الشعر والسحر، ستتعرض للسخرية والاستهزاء، علما بأن الشعر يُدْرَسُ ويُدَرَّسُ. ورغم ذلك يبقى من الأهمية بمكان، لمن أراد قرض الشعر، أن يصاحب نزار قباني أو أدونيس ردحا من الزمن، أو يعرف كيف يتآلف مع شعرهما، بدلا من حضور تلك الدروس. السحر أيضا، يُدْرَسُ و يُدَرَّسُ. وقد أخذ ابن خلدون دروسا منه، وسطر شيئا من ذلك في كتاباته، دون أن يكون هو نفسه ساحرا. إن الساحر المبتدئ يحتاج إلى كبير السحرة لإرشاده وحمايته من خطر المثل المأثور:أن "ينقلب السحر على الساحر"، أي أن يطلق أحداثا ليس هو سيد الموقف فيها ويمكن أن تودي به. فهاجسُ الخوف من مثل تلك المغامرات، ينبغي أن يكون حاضرا - أكثر من أي هاجس آخر- في أذهان الساسة الناشئين، فضلا عن الكُمَّل. فرجل السياسة مشدود دائما بلجامين متينين: أولهما الاحتراز من المغامرة، التي هي ليست الجراءة، حسب اكلوزوفيتش الذي يرى أن "الجرأة القصوى، قد تتفق مع الحكمة القصوى أحيانا ". أما اللجام الثاني، فهو التمسك بالأخلاقيات التي تحكم دائما السياسة الرفيعة. لا أحد يشبه رجل السياسة عندما يتفانى في العمل، بقلبه وقالبه، كالذي يحاول استرجاع بيته الشخصي المغتصب من طرف الغير، لا يدَّخر وقتا ولا تعوقه أي منفعة شخصية، مضحيا بحياته الخاصة وأحيانا بحريته، فقط من أجل مصير أفضل لملايين البؤساء، الذين لا يعون أي حق لهم ولا يميزون، سحقهم الاحباط والاستسلام للقدر. يعرفون شيئا واحدا فقط هو: أن هناك ظلما نازلا من السماء لا مرد له، تنفذه بكل دقة ومثابرة أيادي بشرية. هذه قمة في الفضل. لحد الآن لا يوجد أعلى منها في سلم القيم الإنسانية، إنها أرفع حتى من محكوم بالإعدام يقال له أنت حر طليق. شيء مثل هذا لا يداس بالأقدام إلا في المجتمعات التي تحتقر الفلسفة وتنكر قيمة الإنسان. إن مجالا كهذا يتطلب كمّا من المؤهلات الذهنية، كرجاحة العقل وعمق التفكير ونعومة التصرفات، وكثيرا أيضا من القيم القلبية كالثقة في الفطرة الطيبة للإنسان وقدرته على التطور نحو الأحسن، إضافة إلى احترام الغير والزهد والتواضع ... فهل يمكن لمثل هذا المجال أن يتحول، بين أيدينا، إلى بهلوانيات تنتج رجالا بلا قيم؟. يعتقد توكفيل أنه في بعض البلدان التي احترقت بنيتها الاجتماعية "تسقط الطبقة السياسية في الهمجية في الوقت الذي يجنح فيه المجتمع المدني نحو التنوُّع". حتى في وقت الحرب، لا يُعفى الرجال أنفسَهم من التقيد بقيمهم الرفيعة، وأساسِ وجودِهم الذي جعلهم ما هم عليه - بعبارة أخرى- منحهم شرعيتهم. إننا نتخذ مواقف ونقْدم على تصرفات، لقناعتنا بأن الآخرين يشرعون لنا ذلك. وإذا كان هذا المكسب الضمني غير موجود، أو لم يعد موجودا، أو تضرر بتصرفات قادحة، فنحن فاقدو الشرعية. ولسنا بحاجة هنا إلى اتخاذ قرار بالانسحاب من اللعبة، لأن الانسحاب يتسلل من تلقاء نفسه إلى الأذهان، وذلك أوضح وأبلغ من الإعلان الشكلي الصارخ. في غمار الثورة العربية الكبرى التي أطلقها شريف مكة عام 1916، من أجل تحرير العرب من قبضة الترك، علم الأمير فيصل، ابن الشريف، بأن الحامية التركية بالمدينة والتي يحاصرها، تعاني من نقص فظيع في مادة التبغ. وبما أنه كان مدخنا كبيرا، لم يحتمل تلك المعاناة النفسية التي يكابدها أعداؤه، فما كان منه إلا أن أرسل لهم عدة جمال محملة بالتبغ مع الاعتذار لهم. وذات مساء من أماسي حرب الريف التي قادها عبد الكريم الخطابي المغربي ، كان أحد الضباط الفرنسيين يستقبل بعثة من الثوار الوطنيين في الجبل، وفجأة تعرض مركز القيادة الاستعمارية للهجوم من طرف مجموعة من الثوار لم تكن على علم بالمفاوضات. فطلب الضابط الفرنسي من الثوار أن يغادروا على عجل، فأجابوه بأن شرفهم لا يسمح لهم بتركه في مثل تلك الوضعية، لأنهم كانوا ضيوفا عنده. فما كان منهم إلا أن قاتلوا إخوانهم، حتى أنقذوا مركز قيادة العدو، وبعدها لحقوا برجال المقاومة. وأثناء الحملات المتتالية التي خاضها ملك السويد اللامع، شارل الثاني عشر، ضد روسيا، كان القيصر بطرس الأكبر يحشد كل قواته في جبهة واسعة لصد هجوم خصمه المتقد. فكان هذا الأخير يلاحظ كل مرة رقة وهزال خط الدفاع الذي يواجهه، فيدفع بجيشه لإحداث ثغرة ويلتف على الجيش الروسي، وفي كل مرة يحصل تحطم تام للمُدافع. وفي كل مرة يبعث الملك أسراه إلى بلده السويد باستثناء الجنرالات الذين يعيدهم إلى القيصر مع التهاني. لأنه يرى من غير اللائق حرمان عدوه في الحملة القادمة من قيادة بهذا المستوى من المثابرة، وبعد سلسلة من الهزائم للجيش الروسي، أوحى أحد هؤلاء الجنرالات لبطرس الأكبر بأن تتابع النكسات قد يعود إلى أسلوبهم في القتال، وإنه سيكون من المفيد استبدال مبدأ الخط المتصل بنظام نقاط المقاومة المركزة، فقبل الاقتراح. عندها تكسر الهجوم السويدي على صخرة الدفاعات المدعمة الروسية، وأدى الهجوم المضاد للروس إلى سحق جيوش شارل الثاني عشر. وفي هذه المرة، أقام بطرس الأكبر حفل استقبال على شرف أسراه من الجنرالات السويديين ليرفع لهم الكأس قائلا: "على شرفكم أنتم أساتذتنا في فنون الحرب". هكذا يتم النصر والهزيمة، بكبرياء. كلا الخصمين باعترافه بقيمة الآخر وسلوكه النبيل ارتقى إلى قمة العزة. لم تنطو بوادر النبل هذه على أي مؤشر للصداقة، أو رغبة في السلام. لقد استطاع الرجلان- في هذا الجو من العداوة القصوى - أن يتجنبا كل ما من شأنه الحط من قيمتهما، فتفننا في البرهنة على أنهما أهل لما هما عليه من السمو. أولاد امبارك، أيضا، أحجموا مرة فيما يقال عن مهاجمة أعداء لهم، كانوا في متناول بنادقهم. والسبب أنهم لم يكونوا أتموا لبس سراويلهم. فما كان من أولاد امبارك إلا أن ولو ظهورهم لهؤلاء الخصوم كي يتمكنوا من لبس سراويلهم على الوجه الذي يريدون. لقد خافوا أن تلطخ الانتهازية سمعتهم، وأن يلاحقهم ذكر سيء، يتبعهم خلفا عن سلف. من ينظر اليوم إلى سمعته بهذا البعد. الغلو في السياسة يمكن استساغته على مستوى المبادئ، بل إنه - في بعض الظروف- فضيلة ومنقبة. هذا ما يسمى بالتطرف. وهو غير مستحسن في الفكر باتجاه اليمين، أما يسارا فهو مقبول لأنه لا ينفك عن العقل والأخلاق. فلا أحد أشد تطرفا من تروتسكي، على مستوى المبادئ. إلا أنه قل من يماثله في الانضباط والالتزام بالأخلاقيات السياسية. اتشي غيفارا أيضا، بإنسانيته الثورية، يعتبر مثالا حيا للتطرف اليساري. وكذلك ماركيز ونظريته النقدية الراديكالية. في المناهج يسمى التطرف اليساري، "الصبيانية" فهو يؤدي، في الغالب، إلى كوارث أو، يقود إلى طريق مسدود. أما التطرف اليميني في العمل، فيسمى بالفاشية، وقد ترسخت دلالته القدْحية المعروفة. أما التجاوزات اللفظية، فلا تنتمي حقيقة إلى مدرسة معينة. وإذا كان من الضروري إيجاد أصول مدرسية لها فلن يكون شيء أقرب لها من الفاشية، التي أفرطت في استعمالها عبر تاريخها. وفي المقابل، لن يكون من السهل بأي حال من الأحوال، ربط التجاوزات اللفظية بالديمقراطية الحقيقية، التي تأسست وعمت أوروبا مطلع القرن الماضي، بعد سقوط الامبراطوريات. لأن الميزة الأساسية لتلك الديمقراطية هي الاعتدال. فبدون الاعتدال، لا يمكن الوصول إلى الديمقراطية. إننا، وبكل بساطة عالقون ما بين ديكتاتوريتين، واحدة فررنا منها وأخرى نميل لها ونسعى إليها، بدقة الصائغ وصبر أيوب. للديمقراطية ضمانتان: الأولى، هي وجود طبقة سياسية واعية، قد راجعت نفسها وتكيفت ، وطوت نهائيا صفحة العنف اللفظي والجسدي. أما الثانية، فهي شعب مستنير، اختار وتذوق طعم الأساليب الهادئة، ويمنح ثقته نهائيا للطبقة السياسية العاملة وأطروحاتها، لأنها جديرة بذلك. وهو أمر يختلف عن التعلق بزعيم سياسي، فالتعلق بزعيم سياسي معين لا يحسم أمرا ولا يعني ثقة الشعب في طبقته السياسية. فتعلق الجماهير وثقتها في أدولف هتلر، أيام جمهورية ويمار، لم يكن مؤشرا على ثقتها في الطبقة السياسية هناك، وإنما العكس هو الصحيح. وهذا بالذات ما أحل الدمار بتلك الجمهورية المثالية، في نصوصها وسيرها. قد لا نصوت لزعيم ما، لكننا نثق به نثق بأنه ليس حاقدا ولا سيء النية ولا انتقاميا. وبمعنى آخر، هو مأمون الشر، كل المشكلة هي: مأمون الشر؟! إن الذين يصفون أنفسهم، أو يوصفون بأنهم معارضة راديكالية، تضيع أفكارهم في سيل الكلام المفرط والتخمينات والشعارات. ولذلك، لمّا تناولوا موضوعا أساسيا في حياة الشعب، مثل برنامج مساعدة المنمين ضاع كل ما تقدموا به من الكلام الصحيح أو المفيد، وسط الزبد. والأسوأ من ذلك، أن رحيل النظام، الذي اتخذوه شعارا أساسيا لهم، يتحركون تحت رايته، بعيد كل البعد عن الواقع.. لأنه لا تتوفر أي شروط ذاتية لتحققه. أما الشروط الموضوعية، فلا تسمح حتى بالتلميح إليه. ولا شك هنا، أن الذين لهم دراية بالنظرية السياسية من بين هؤلاء، كانوا مهمّشين وقت صياغة هذا الشعار، أو لم يجدوا من يصغي إليهم. ففي السياسة أوقات وحالات لا تسعفنا فيها الحِرفية السياسية، وتلفيق الهواة. إنها القصة نفسها التي تتكرر دائما، حيث الساسة الجادون - بطبعهم أو تكوينهم أو أفكارهم - يطغى عليهم صوت الآخرين, لأنه وسط الضوضاء، لا يسمع إلا صوت الذين يصرخون. لقد رفعوا سقف المطالب عاليا. والمشكل، أنه عندما لا نحقق هدفنا، فما سيأتي بعد ذلك خطير من الناحية السياسية. فإنه يسد الباب أمام المستقبل، فحتى الأفكار الواقعية والأهداف المعقولة، لم يعد أحد يأخذها بعين الجد أو يحسبها قابلة للتطبيق. إنه لمسعى خطير على المعارضة نفسها، وهو أشبه بالحجر الذي تحدث عنه قائد الصين العصرية، ماو سي تونغ. يقول ماو: إن القوة التي لا تتناغم مع زمانها تنكبُّ بيديها على صخرة الظلم الثقيلة، ترفعها بصعوبة فائقة وتوجب على نفسها أن تبلغ بها أقصى ارتفاع. عندما تصل مستوى الرأس يحس الساعدان بالإنهاك ويخذلانها. لم يعد لديهما من القوة ما يحفظها مرفوعة ولا ما ينزلها بأمان. الصخرة منفلتة لا محالة، ومحطمة للقدمين. هذا هو الخطر. إذا كان الناس قد اختاروا الديمقراطية وسعدوا بوجودها، فذلك لأنها هي الأمثل. لأنها نظام الحرية، ولأنها متلازمة مع العدالة ولأنها تسمح بحل المشاكل اليومية بطرق مرنة وفعّالة، أو لنقل: طرق آلية. فبدون هذا الوصف الأخير، لن نقترب من فهم المواطنين وتفهّمهم للديمقراطية. لكن مع اجتماع كل هذه الأمور، وأمور أخرى مهمة، فإننا إذا دخلنا حرب عصابات سياسية وقانونية وإجرائية هدفها العرقلة والتشويش، ولم يحصل لدينا الاتفاق على الأساسيات - كالدستور والقوانين والانتخابات، والمصالح العليا للبلد، ومن هو صاحب القرار- إذا لم يبق أي شيء من هذا ولم يعد هناك شخص محترم أو مهاب، وإذا بقينا نتشبث بالشكليات وثانويات الأمور، كلما أردنا معالجة مشاكل البلد، إذا أبقينا البلد في حالة دائمة التوتر، لا موضوع لها ولا مسوّغ، إذا كانت طاقة المسؤولين الرسميين وغير الرسميين واهتماماتهم منصبة على أومور لا معنى لها ولا فائدة فيها ... فإن الديمقراطية ستثبت عدم فاعليتها بل ضررها، وأنها أسلوب للحكم غير متكيف. وعندئذ، سيهجرها الكل، ويوليها ظهره، متجها نحو النقيض. عند ذلك ندشن مرحلة جديدة من الارتياب، غنية بالغموض. ومن الصعب الاعتقاد بأن البلد قادر على أن يتحمل - إلى الأبد- هذا التجمد والابتزاز بالخنق. هكذا زالت جمهورية ويمار الفاضلة الجميلة، لأنها أسست على مقاس أصحاب الفكر الرفيع، فاستطاعت ثلة من الأوغاد، بصناديق الاقتراع والشارع، أن تزيحها وتبني مكانها نقيضا، وسط حماس شعب سئم المماحكات والمناكفات الفارغة، ويريد العمل الجدي. المأساة أن طاقم ويمار، كان من ذوي الفكر الراقي، ولم يفكروا في أن تراكم التصرفات الجانبية والتسويف أمام الخطر، وعدم التصدي للإشكالات الأساسية وانعدام الوعي والمسؤولية لدى جماعة البرلمانيين "البيزنطيين"، إضافة إلى العجز عن اقتلاع وعزل أعداء الديمقراطية ... لم يدركوا أن كل هذه العوامل يمكن أن تقضي على نظام كامل، كان الشعب قد أجمع على اختياره في البداية، فأنتج له في آخر المطاف هذا الغول النازي. كانت الديمقراطية الألمانية راسخة. فالشعب مثقف والنخبة لامعة، إلا أن الطبقة السياسية لم تكن على مستوى ذلك البلد. أما ديمقراطيتنا فقد جاءت مهداة على نقالة، لم تفرضها أي قوة ولم تطالب بها، بصفة جدية، أي جهة. في عهد الحزب الواحد، كان هناك كم غفير من المعارضين، قدموا كل أشكال التصورات والأفكار، وكانت لهم مطالب لا حد لها، يناضلون من أجلها. غير أن الديمقراطية التعددية، لم تكن يوما ضن تلك المطالب. وكان النظام القائم آنذاك يعتبرها فكرة ومبدأ إجراميا، بنص الدستور والقوانين، وخيانة تهدف إلى شق الوحدة الوطنية للشعب الموريتاني. حتى إن نشر الفكر الماركسي والبعثي كان أقل خطرا حينئذ من الدعوة إلى الديمقراطية. والحقيقة، أن بعض الأشخاص، المعدودين على أصابع اليد، ظلوا يؤمنون بأن التعددية السياسية هي أمثل طريقة للحكم. من بين هؤلاء، كان المرحوم حمود ولد أحمدو، الرئيس السابق للجمعية الوطنية. شيخنا ولد محمد الأغظف، وزير الخارجية الأسبق. إسماعيل ولد أعمر، مؤسس شركة اسنيم. احمد ولد سيدي باب، وزير سابق. المرحوم با ممادو صمبابولي، رئيس سابق للجمعية الوطنية بالطبع لا يوجد هنا زحام .. إنها فقط شخصيات لم تستوعب يوما مبدأ الحزب الواحد. altالذين يصرخون على أي حال، "الكياسة هبة الطبيعة"، كما يقول باسكال. لقد كان الاعتقاد سائدا إلى وقت قريب، بأن أول واجبات رجل السياسة، معرفة ضرورة الاعتدال، وأن يرسم لنفسه حدودا فليس كل من وجد أمامه مكبرا للصوت، أو حاز مأمورية انتخابية وتمتع بحصانة قانونية، أو انعدم لديه الخوف من الإلقاء في السجن بضع سنين، كما كان يحدث في الفترات الماضية.. عليه أن يتفوه بكل مكبوتاته من الشتائم والسّباب. التهتّـك جعل البعض يصرخون في مكبرات الصوت، مع العلم أنها لم تخترع إلا لتغني عن ذلك الصراخ، إن الحجة، أي الفكرة التي تهدف إلى الإقناع، غنية عن الصراخ، لأنها موجهة للعقول لا إلى الآذان. رجل الصراخ لا يوثق به. من يقذف بكل ما يجيش في نفسه من جيد أو ردئ لم يخلق للسياسة. فضلا عن ذلك هل كل ما ليس محرما هو مباح؟ كان الشيخ آمادو مؤسس امبراطورية ماسينا الفلاَّنية رجلا ورعا مستقيما، زاهدا. وكان يَسُوس دولته بواسطة مجلس علمي من ستين فقيها يحيطون به بصفة دائمة ويقررون كل شيء، كانوا متشددين حَرْفيين يقلدون نظام المدينة المنورة أيام الخلفاء الأولين. بالنسبة لهم الأمور بسيطة إما محرمة أو مباحة. لقد قال رينيه كاييه المعروف في مجتمعنا بـ"ولد كيج" الذي جاب الساحل وعبر الصحراء، حوالي 1824-1828 "إن الفلان أشد تعصبا من البيضان". للشيخ آمادو -إضافة إلى ما ذكرنا- ميزة أخرى هي الذكاء. كان يعرف أن الأمور ليست بالبساطة التي يراها الفقهاء. ولكي يفتح أعينهم أمر يوما بإعداد مائدة من اللحم أضاف إليها لحم الضب والجراد وحشرات أخرى. ودعاهم للأكل، فقالوا إنهم لا يأكلون مثل هذه اللحوم. فقال الشيخ إن الشرع لا يحرم أكلها!. فقالوا: نعلم ذلك! فقال: "إذن هناك أشياء لا يحرمها الشرع ومع ذلك يتعين علينا تركها.. وهذا ماعلينا أخذه في الحسبان مستقبلا". إن السياسة - من حيث هي رسالة - من أسمى وأجزل ما أنتجه البشر. صحيح أن الفلسفة تحوم فوقها، إلا أنهما تلتقيان عند مستوى معين. لأنه، "في السياسة، تتلخص الفلسفة" كما يقول اغرامشي. ويذهب ماركيز، أبعد من ذلك ويعكسه قائلا: " إن دور السياسة هو تحليل مضامين المفاهيم الفلسفية، للوصول إلى حقيقة غير مشوهة". إنها إنسانوية النهضة الأوروبية التي جاءت بهذا الربط الرائع، جاعلة من الإنسان قيمة عليا. أما الأيديولوجيا، فجاءت بعد ذلك بكثير، من أجل إضفاء التماسك والانسجام على المبادئ السياسية، وربط الوسائل بالغايات وجعلهما أكثر تطابقا. كثيرا ما يوردون علم الاقتصاد إلى جانب السياسة. إن ذلك خال من المعنى. إن الاقتصاد هو خادم للنظام الاجتماعي السائد. القانون هو الآخر مجرد خادم بسيط لذلك النظام. أما السياسة، فهي ساحرة. مكانُها سماء المعارف، في تلك المجرة حيث الشعر وربما السحر، لا لقيمة الأخيرين وقدرهما، وإنما لاستقلاليتهما واستبدادهما. أي جامعة تمنح شهادات الشعر والسحر، ستتعرض للسخرية والاستهزاء، علما بأن الشعر يُدْرَسُ ويُدَرَّسُ. ورغم ذلك يبقى من الأهمية بمكان، لمن أراد قرض الشعر، أن يصاحب نزار قباني أو أدونيس ردحا من الزمن، أو يعرف كيف يتآلف مع شعرهما، بدلا من حضور تلك الدروس. السحر أيضا، يُدْرَسُ و يُدَرَّسُ. وقد أخذ ابن خلدون دروسا منه، وسطر شيئا من ذلك في كتاباته، دون أن يكون هو نفسه ساحرا. إن الساحر المبتدئ يحتاج إلى كبير السحرة لإرشاده وحمايته من خطر المثل المأثور:أن "ينقلب السحر على الساحر"، أي أن يطلق أحداثا ليس هو سيد الموقف فيها ويمكن أن تودي به. فهاجسُ الخوف من مثل تلك المغامرات، ينبغي أن يكون حاضرا - أكثر من أي هاجس آخر- في أذهان الساسة الناشئين، فضلا عن الكُمَّل. فرجل السياسة مشدود دائما بلجامين متينين: أولهما الاحتراز من المغامرة، التي هي ليست الجراءة، حسب اكلوزوفيتش الذي يرى أن "الجرأة القصوى، قد تتفق مع الحكمة القصوى أحيانا ". أما اللجام الثاني، فهو التمسك بالأخلاقيات التي تحكم دائما السياسة الرفيعة. لا أحد يشبه رجل السياسة عندما يتفانى في العمل، بقلبه وقالبه، كالذي يحاول استرجاع بيته الشخصي المغتصب من طرف الغير، لا يدَّخر وقتا ولا تعوقه أي منفعة شخصية، مضحيا بحياته الخاصة وأحيانا بحريته، فقط من أجل مصير أفضل لملايين البؤساء، الذين لا يعون أي حق لهم ولا يميزون، سحقهم الاحباط والاستسلام للقدر. يعرفون شيئا واحدا فقط هو: أن هناك ظلما نازلا من السماء لا مرد له، تنفذه بكل دقة ومثابرة أيادي بشرية. هذه قمة في الفضل. لحد الآن لا يوجد أعلى منها في سلم القيم الإنسانية، إنها أرفع حتى من محكوم بالإعدام يقال له أنت حر طليق. شيء مثل هذا لا يداس بالأقدام إلا في المجتمعات التي تحتقر الفلسفة وتنكر قيمة الإنسان. إن مجالا كهذا يتطلب كمّا من المؤهلات الذهنية، كرجاحة العقل وعمق التفكير ونعومة التصرفات، وكثيرا أيضا من القيم القلبية كالثقة في الفطرة الطيبة للإنسان وقدرته على التطور نحو الأحسن، إضافة إلى احترام الغير والزهد والتواضع ... فهل يمكن لمثل هذا المجال أن يتحول، بين أيدينا، إلى بهلوانيات تنتج رجالا بلا قيم؟. يعتقد توكفيل أنه في بعض البلدان التي احترقت بنيتها الاجتماعية "تسقط الطبقة السياسية في الهمجية في الوقت الذي يجنح فيه المجتمع المدني نحو التنوُّع". حتى في وقت الحرب، لا يُعفى الرجال أنفسَهم من التقيد بقيمهم الرفيعة، وأساسِ وجودِهم الذي جعلهم ما هم عليه - بعبارة أخرى- منحهم شرعيتهم. إننا نتخذ مواقف ونقْدم على تصرفات، لقناعتنا بأن الآخرين يشرعون لنا ذلك. وإذا كان هذا المكسب الضمني غير موجود، أو لم يعد موجودا، أو تضرر بتصرفات قادحة، فنحن فاقدو الشرعية. ولسنا بحاجة هنا إلى اتخاذ قرار بالانسحاب من اللعبة، لأن الانسحاب يتسلل من تلقاء نفسه إلى الأذهان، وذلك أوضح وأبلغ من الإعلان الشكلي الصارخ. في غمار الثورة العربية الكبرى التي أطلقها شريف مكة عام 1916، من أجل تحرير العرب من قبضة الترك، علم الأمير فيصل، ابن الشريف، بأن الحامية التركية بالمدينة والتي يحاصرها، تعاني من نقص فظيع في مادة التبغ. وبما أنه كان مدخنا كبيرا، لم يحتمل تلك المعاناة النفسية التي يكابدها أعداؤه، فما كان منه إلا أن أرسل لهم عدة جمال محملة بالتبغ مع الاعتذار لهم. وذات مساء من أماسي حرب الريف التي قادها عبد الكريم الخطابي المغربي ، كان أحد الضباط الفرنسيين يستقبل بعثة من الثوار الوطنيين في الجبل، وفجأة تعرض مركز القيادة الاستعمارية للهجوم من طرف مجموعة من الثوار لم تكن على علم بالمفاوضات. فطلب الضابط الفرنسي من الثوار أن يغادروا على عجل، فأجابوه بأن شرفهم لا يسمح لهم بتركه في مثل تلك الوضعية، لأنهم كانوا ضيوفا عنده. فما كان منهم إلا أن قاتلوا إخوانهم، حتى أنقذوا مركز قيادة العدو، وبعدها لحقوا برجال المقاومة. وأثناء الحملات المتتالية التي خاضها ملك السويد اللامع، شارل الثاني عشر، ضد روسيا، كان القيصر بطرس الأكبر يحشد كل قواته في جبهة واسعة لصد هجوم خصمه المتقد. فكان هذا الأخير يلاحظ كل مرة رقة وهزال خط الدفاع الذي يواجهه، فيدفع بجيشه لإحداث ثغرة ويلتف على الجيش الروسي، وفي كل مرة يحصل تحطم تام للمُدافع. وفي كل مرة يبعث الملك أسراه إلى بلده السويد باستثناء الجنرالات الذين يعيدهم إلى القيصر مع التهاني. لأنه يرى من غير اللائق حرمان عدوه في الحملة القادمة من قيادة بهذا المستوى من المثابرة، وبعد سلسلة من الهزائم للجيش الروسي، أوحى أحد هؤلاء الجنرالات لبطرس الأكبر بأن تتابع النكسات قد يعود إلى أسلوبهم في القتال، وإنه سيكون من المفيد استبدال مبدأ الخط المتصل بنظام نقاط المقاومة المركزة، فقبل الاقتراح. عندها تكسر الهجوم السويدي على صخرة الدفاعات المدعمة الروسية، وأدى الهجوم المضاد للروس إلى سحق جيوش شارل الثاني عشر. وفي هذه المرة، أقام بطرس الأكبر حفل استقبال على شرف أسراه من الجنرالات السويديين ليرفع لهم الكأس قائلا: "على شرفكم أنتم أساتذتنا في فنون الحرب". هكذا يتم النصر والهزيمة، بكبرياء. كلا الخصمين باعترافه بقيمة الآخر وسلوكه النبيل ارتقى إلى قمة العزة. لم تنطو بوادر النبل هذه على أي مؤشر للصداقة، أو رغبة في السلام. لقد استطاع الرجلان- في هذا الجو من العداوة القصوى - أن يتجنبا كل ما من شأنه الحط من قيمتهما، فتفننا في البرهنة على أنهما أهل لما هما عليه من السمو. أولاد امبارك، أيضا، أحجموا مرة فيما يقال عن مهاجمة أعداء لهم، كانوا في متناول بنادقهم. والسبب أنهم لم يكونوا أتموا لبس سراويلهم. فما كان من أولاد امبارك إلا أن ولو ظهورهم لهؤلاء الخصوم كي يتمكنوا من لبس سراويلهم على الوجه الذي يريدون. لقد خافوا أن تلطخ الانتهازية سمعتهم، وأن يلاحقهم ذكر سيء، يتبعهم خلفا عن سلف. من ينظر اليوم إلى سمعته بهذا البعد. الغلو في السياسة يمكن استساغته على مستوى المبادئ، بل إنه - في بعض الظروف- فضيلة ومنقبة. هذا ما يسمى بالتطرف. وهو غير مستحسن في الفكر باتجاه اليمين، أما يسارا فهو مقبول لأنه لا ينفك عن العقل والأخلاق. فلا أحد أشد تطرفا من تروتسكي، على مستوى المبادئ. إلا أنه قل من يماثله في الانضباط والالتزام بالأخلاقيات السياسية. اتشي غيفارا أيضا، بإنسانيته الثورية، يعتبر مثالا حيا للتطرف اليساري. وكذلك ماركيز ونظريته النقدية الراديكالية. في المناهج يسمى التطرف اليساري، "الصبيانية" فهو يؤدي، في الغالب، إلى كوارث أو، يقود إلى طريق مسدود. أما التطرف اليميني في العمل، فيسمى بالفاشية، وقد ترسخت دلالته القدْحية المعروفة. أما التجاوزات اللفظية، فلا تنتمي حقيقة إلى مدرسة معينة. وإذا كان من الضروري إيجاد أصول مدرسية لها فلن يكون شيء أقرب لها من الفاشية، التي أفرطت في استعمالها عبر تاريخها. وفي المقابل، لن يكون من السهل بأي حال من الأحوال، ربط التجاوزات اللفظية بالديمقراطية الحقيقية، التي تأسست وعمت أوروبا مطلع القرن الماضي، بعد سقوط الامبراطوريات. لأن الميزة الأساسية لتلك الديمقراطية هي الاعتدال. فبدون الاعتدال، لا يمكن الوصول إلى الديمقراطية. إننا، وبكل بساطة عالقون ما بين ديكتاتوريتين، واحدة فررنا منها وأخرى نميل لها ونسعى إليها، بدقة الصائغ وصبر أيوب. للديمقراطية ضمانتان: الأولى، هي وجود طبقة سياسية واعية، قد راجعت نفسها وتكيفت ، وطوت نهائيا صفحة العنف اللفظي والجسدي. أما الثانية، فهي شعب مستنير، اختار وتذوق طعم الأساليب الهادئة، ويمنح ثقته نهائيا للطبقة السياسية العاملة وأطروحاتها، لأنها جديرة بذلك. وهو أمر يختلف عن التعلق بزعيم سياسي، فالتعلق بزعيم سياسي معين لا يحسم أمرا ولا يعني ثقة الشعب في طبقته السياسية. فتعلق الجماهير وثقتها في أدولف هتلر، أيام جمهورية ويمار، لم يكن مؤشرا على ثقتها في الطبقة السياسية هناك، وإنما العكس هو الصحيح. وهذا بالذات ما أحل الدمار بتلك الجمهورية المثالية، في نصوصها وسيرها. قد لا نصوت لزعيم ما، لكننا نثق به نثق بأنه ليس حاقدا ولا سيء النية ولا انتقاميا. وبمعنى آخر، هو مأمون الشر، كل المشكلة هي: مأمون الشر؟! إن الذين يصفون أنفسهم، أو يوصفون بأنهم معارضة راديكالية، تضيع أفكارهم في سيل الكلام المفرط والتخمينات والشعارات. ولذلك، لمّا تناولوا موضوعا أساسيا في حياة الشعب، مثل برنامج مساعدة المنمين ضاع كل ما تقدموا به من الكلام الصحيح أو المفيد، وسط الزبد. والأسوأ من ذلك، أن رحيل النظام، الذي اتخذوه شعارا أساسيا لهم، يتحركون تحت رايته، بعيد كل البعد عن الواقع.. لأنه لا تتوفر أي شروط ذاتية لتحققه. أما الشروط الموضوعية، فلا تسمح حتى بالتلميح إليه. ولا شك هنا، أن الذين لهم دراية بالنظرية السياسية من بين هؤلاء، كانوا مهمّشين وقت صياغة هذا الشعار، أو لم يجدوا من يصغي إليهم. ففي السياسة أوقات وحالات لا تسعفنا فيها الحِرفية السياسية، وتلفيق الهواة. إنها القصة نفسها التي تتكرر دائما، حيث الساسة الجادون - بطبعهم أو تكوينهم أو أفكارهم - يطغى عليهم صوت الآخرين, لأنه وسط الضوضاء، لا يسمع إلا صوت الذين يصرخون. لقد رفعوا سقف المطالب عاليا. والمشكل، أنه عندما لا نحقق هدفنا، فما سيأتي بعد ذلك خطير من الناحية السياسية. فإنه يسد الباب أمام المستقبل، فحتى الأفكار الواقعية والأهداف المعقولة، لم يعد أحد يأخذها بعين الجد أو يحسبها قابلة للتطبيق. إنه لمسعى خطير على المعارضة نفسها، وهو أشبه بالحجر الذي تحدث عنه قائد الصين العصرية، ماو سي تونغ. يقول ماو: إن القوة التي لا تتناغم مع زمانها تنكبُّ بيديها على صخرة الظلم الثقيلة، ترفعها بصعوبة فائقة وتوجب على نفسها أن تبلغ بها أقصى ارتفاع. عندما تصل مستوى الرأس يحس الساعدان بالإنهاك ويخذلانها. لم يعد لديهما من القوة ما يحفظها مرفوعة ولا ما ينزلها بأمان. الصخرة منفلتة لا محالة، ومحطمة للقدمين. هذا هو الخطر. إذا كان الناس قد اختاروا الديمقراطية وسعدوا بوجودها، فذلك لأنها هي الأمثل. لأنها نظام الحرية، ولأنها متلازمة مع العدالة ولأنها تسمح بحل المشاكل اليومية بطرق مرنة وفعّالة، أو لنقل: طرق آلية. فبدون هذا الوصف الأخير، لن نقترب من فهم المواطنين وتفهّمهم للديمقراطية. لكن مع اجتماع كل هذه الأمور، وأمور أخرى مهمة، فإننا إذا دخلنا حرب عصابات سياسية وقانونية وإجرائية هدفها العرقلة والتشويش، ولم يحصل لدينا الاتفاق على الأساسيات - كالدستور والقوانين والانتخابات، والمصالح العليا للبلد، ومن هو صاحب القرار- إذا لم يبق أي شيء من هذا ولم يعد هناك شخص محترم أو مهاب، وإذا بقينا نتشبث بالشكليات وثانويات الأمور، كلما أردنا معالجة مشاكل البلد، إذا أبقينا البلد في حالة دائمة التوتر، لا موضوع لها ولا مسوّغ، إذا كانت طاقة المسؤولين الرسميين وغير الرسميين واهتماماتهم منصبة على أومور لا معنى لها ولا فائدة فيها ... فإن الديمقراطية ستثبت عدم فاعليتها بل ضررها، وأنها أسلوب للحكم غير متكيف. وعندئذ، سيهجرها الكل، ويوليها ظهره، متجها نحو النقيض. عند ذلك ندشن مرحلة جديدة من الارتياب، غنية بالغموض. ومن الصعب الاعتقاد بأن البلد قادر على أن يتحمل - إلى الأبد- هذا التجمد والابتزاز بالخنق. هكذا زالت جمهورية ويمار الفاضلة الجميلة، لأنها أسست على مقاس أصحاب الفكر الرفيع، فاستطاعت ثلة من الأوغاد، بصناديق الاقتراع والشارع، أن تزيحها وتبني مكانها نقيضا، وسط حماس شعب سئم المماحكات والمناكفات الفارغة، ويريد العمل الجدي. المأساة أن طاقم ويمار، كان من ذوي الفكر الراقي، ولم يفكروا في أن تراكم التصرفات الجانبية والتسويف أمام الخطر، وعدم التصدي للإشكالات الأساسية وانعدام الوعي والمسؤولية لدى جماعة البرلمانيين "البيزنطيين"، إضافة إلى العجز عن اقتلاع وعزل أعداء الديمقراطية ... لم يدركوا أن كل هذه العوامل يمكن أن تقضي على نظام كامل، كان الشعب قد أجمع على اختياره في البداية، فأنتج له في آخر المطاف هذا الغول النازي. كانت الديمقراطية الألمانية راسخة. فالشعب مثقف والنخبة لامعة، إلا أن الطبقة السياسية لم تكن على مستوى ذلك البلد. أما ديمقراطيتنا فقد جاءت مهداة على نقالة، لم تفرضها أي قوة ولم تطالب بها، بصفة جدية، أي جهة. في عهد الحزب الواحد، كان هناك كم غفير من المعارضين، قدموا كل أشكال التصورات والأفكار، وكانت لهم مطالب لا حد لها، يناضلون من أجلها. غير أن الديمقراطية التعددية، لم تكن يوما ضن تلك المطالب. وكان النظام القائم آنذاك يعتبرها فكرة ومبدأ إجراميا، بنص الدستور والقوانين، وخيانة تهدف إلى شق الوحدة الوطنية للشعب الموريتاني. حتى إن نشر الفكر الماركسي والبعثي كان أقل خطرا حينئذ من الدعوة إلى الديمقراطية. والحقيقة، أن بعض الأشخاص، المعدودين على أصابع اليد، ظلوا يؤمنون بأن التعددية السياسية هي أمثل طريقة للحكم. من بين هؤلاء، كان المرحوم حمود ولد أحمدو، الرئيس السابق للجمعية الوطنية. شيخنا ولد محمد الأغظف، وزير الخارجية الأسبق. إسماعيل ولد أعمر، مؤسس شركة اسنيم. احمد ولد سيدي باب، وزير سابق. المرحوم با ممادو صمبابولي، رئيس سابق للجمعية الوطنية بالطبع لا يوجد هنا زحام .. إنها فقط شخصيات لم تستوعب يوما مبدأ الحزب الواحد. 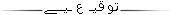
من حكم المتنبي ولم أرى في عيوب الناس عيبا = كنقص القادرين على التمام
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| فصول من حياتي | السوقي الخرجي | المنتدى العام | 84 | 02-11-2013 11:45 AM |
| الهوامش على ( أوراق سوقية للشيخ الخرجي ) | الدغوغي | المنتدى التاريخي | 4 | 09-04-2012 07:11 PM |
| لمحات من تاريخ قرية تنيگي/ إعداد محمد يحيى بن محمد بن احريمو | الخزرجي السوقي | المنتدى التاريخي | 0 | 06-25-2012 06:51 PM |
| تعاليق على مقال محمد أغ محمد : فرق بين الفرار والجهالة | أداس السوقي | المنتدى الإسلامي | 14 | 02-11-2012 09:31 AM |
| محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني | الخزرجي السوقي | منتدى الأعلام و التراجم | 2 | 01-09-2012 08:31 PM |